نظرية الحسبة في النظام الإسلامي أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية
الحلقة الثانية
إدريس محمد عثمان
– نشأة الدولة وتجربة الحسبة:
قبل تحديد مصطلح الدولة الإسلامية يمكن التعرف على نشأتها من خلال بعض المواقف لدعوة النبي e في مكة المكرمة التي حددت قواعد الفكر السياسي للدولة قبل تكوينها وبروز قاعدتها بالمدينة المنورة ، فبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية. أمر الله تعالى النبيe بالجهر بالدعوة ، فقال تعالى : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فتلقى النبي e هذا الأمر الإلهي وانطلق بدعوته الجهرية ، إلا أنّ المشركين وقفوا معاندين، ومعارضين لها ،طاعنين في صدق دعوته ورسالته كما سبق للرسل من قبله قال تعالى: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ وفي هذا دليل على أن كل رسول قد كذِّب فكأنّ الله تعالى قال : لا يزعجك تكذيب قومك ؛ فإن أقواما قبلك كذّبوا ورسلا كُذِّبوا.” ، وبالرغم من عنادهم ومعارضتهم لدعوته سلك النبي طريقه في دعوته والوحي يشد من عضده ،و يحثه على الصبر، ويؤكد له حتمية نصره فيقول الله تعالى : وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ
وقد بذل النبي e جهدا شاقا في سبيل نشر دعوته صابرا محتسبا متيقنا من نصر الله فآمن به من أهل مكة عدد قليل ولكن المشركين أبوا إلا أن يعذبوهم بشتى وسائل التعذيب آنذاك ولم يكن حينها النبي e قادرا على حمايتهم فحثهم على الخروج إلى الحبشة ، فقال : ” لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه” وبخروجهم حدث أول تحول في مسار الدعوة، حيث انتقل صداها من الجزيرة العربية إلى خارجها، وبهذا الحدث اتسعت رقعة الدعوة إلى هذا الدين ، وسمع بها القاصي والداني ، ولكن قريشا أدركت ما في الهجرة من الإعداد للمستقبل فأرسلت إلى ملك الحبشة بطلب رد المهاجرين إلى قومهم باعتبارهم ” فارقوا دين قومهم … وجاءوا بدين مبتدع” ولكن ملك الحبشة بحث أمرهم. ولما علم ما هم فيه رد سفيري قريش دون طلب قومهم ، أمّا في مكة المكرمة فبالرغم من محاصرة قريش للدعوة وصد الناس عنها كان النبي e يخرج بأصحابه إلى شعاب مكة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم ،ويربيهم على الولاء لله تعالى والخروج من عقيدة الجاهلية فكرا وسلوكا. ومع التعذيب والتنكيل بالمؤمنين لمح النبيe بوادر الضعف من بعض أصحابه واستعجالهم النصر ، فغضب ولكنه قرن غضبه بالرجاء و الأمل فحث الصحابة على احتمال الأذى ، واحتساب الأجر عند الله يَقُولُ خَبَّاب ُ t أَتَيْتُ النَّبِيَّ e وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إلاَّ اللَّهَ.” فالرسول e كان على يقين من نصر الله فحثهم على الصبر واسترخاص كل شيء في سبيل الله ، وهناك صور عديدة في سير الصحابة تدل على الالتزام واحتساب الأجر والمثوبة عند الله .وهي مواقف تدل على رسوخ العقيدة في قلوب الصحابة رضوان الله عنهم ، كما تدل على الالتزام والطاعة المطلقة لمنهج الله .
وبالرغم من تعذيب قريش ومقاطعتها لهم مضى النبيe في دعوته وهو يبحث عن منطلقات آمنة بين القبائل وهو يقول : أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي ” وطلب النصر والمنعة كان محاولة لإيجاد مكان آمن للمؤمنين، فالتفكير في المكان “الأرض ” التي يقيم عليها الإسلام دولته لم يكن متأخرا عن نهج رسول الله e وهذا يتضح من خلال الموقف السالف حين أمر الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة إلى الحبشة وفي الموسم من السنة الحادية عشرة بعد البعثة ” اجتهدe في عرض نفسه على القبائل في الموسم فآمن به ستة من رؤساء الأنصار ورجعوا إلى المدينة ففشا فيها الإسلام”
وبإسلام الأنصار برز أول تجمع إسلامي مستقر في جزيرة العرب ” حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة الأولى ، فبايعوا رسول الله e على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفرض عليه الحرب .. ونصها ” بايعنا رسول الله e ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيء من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل ،إن شاء عذب وإن شاء غفر” بهذه البيعة انطلقت الدعوة من عقالها بعد المعاناة التي كابدها الرسول e وصحبه وقد رسمت هذه البيعة أمورا أهمها :
1 – الاستجابة لدعوة التوحيد . وعدم الاشراك بالله وهو الهدف الأساسي الذي كان يسعى له رسول الله e.
2 – رسم الأصول التي سيقوم عليها المجتمع الإسلامي ،كالعفاف والطهر والالتزام بقيم الدين الحنيف وهو مما يدل على ترسيخ قواعد الأحكام مع العقيدة لبناء مجتمع سوي عقيدة وسلوكا.
3 – الالتزام والطاعة لرسول الله e فيما يأمر به و فيما ينهى عنه .
4 – تظهر صورة الاحتساب في هذه البيعة في امتثالهم لأوامر الله ورسوله وإنكارهم كل صور الحياة الجاهلية كالسرقة والقتل والزنا والبهتان.
وقد تلت بيعة العقبة الأولى بيعة ثانية ، قال لهم فيها رسول الله e ” أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم” ويستخلص من هذا القول ابتداء علامات الهجرة إذ النبي e بايع المؤمنين من أهل يثرب على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وطلب الحماية و النصرة ، ما كان بمستطاع أهل يثرب و هو بمكة ؛ لأن قريشا كانت بها أشد وأوثق من أهل يثرب الزائرين لها في المواسم ، ولكن لما عقد النبيeبيعة العقبة الثانية مع أهل يثرب حدث تحول كبير في مسار الدعوة كما قال عبادة بن الصامت t : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ e إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلاَ نَخَافَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فِيهِ وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ e إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ e الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَفَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ e من هذا يتضح أن البيعة الثانية كانت بمثابة عقد التزام بين الرسولe والمؤمنين من أهل يثرب ويتجلى في هذه البيعة الآتي:
أ- السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله e وهذا يدل على رسوخ العقيدة في نفوس المؤمنين.
ب – التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ج – الدفاع عن الدعوة وتبليغها .
د – الدفاع عن رسول الله e في السلم والحرب ابتغاء مرضاة الله تعالى واحتساب ما عنده من مثوبة
هـ– إذا كانت البيعة الأولى رسمت أهم معالم المجتمع الإسلامي ، فإن البيعة الثانية كانت عقد التزام عام فالتزام المؤمنين من أهل يثرب بهذه المعاهدة كانت مسارا جديدا للدعوة ، وهو مرحلة الدفاع عنها وعن النبي e.
ويذهب بعض الباحثين إلى إن الفكر السياسي للدولة الإسلامية التي تشكلت بهيكلها التنظيمي في المدينة المنورة كان نتاج البيعتين السالفتين، وعدوا الأخيرة بمثابة حجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية.
ومما يعزز هذا الرأي أن دعوة النبيe منذ انبلاجها كانت ولا تزال واضحة الملامح ترسم الخطوط البينة للمجتمع الإيماني وتشكله بصورة تخالف كل صور الجاهلية قديمها وحديثها عقيدة، وفكرا ، وسلوكا .فقد كانت بيعة العقبة الأولى والثانية بمثابة : العقود الاجتماعية التي بدا لبعض فلاسفة السياسة في العصور الحديثة أن يتأملوها معتبرين أنها الأساس الذي تقوم عليه الدول والحكومات وإن العقد الذي حدث هنا مرتين عند العقبة وقامت على أساسه الدولة الإسلامية عقد تاريخي ، وهو حقيقة يعرفها الجميع تم فيه الاتفاق بين إيرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية.
وبعد معاهدة الالتزام في العقبة الثانية أذن الرسول e للصحابة بالهجرة إلى المدينة ، فخرجوا إليها أفرادا وجماعات. حتى لحق بهم وبهجرته إلى المدينة المنورة تكاملت أركان الدولة الإسلامية، عندما وجدت الأمة إقليما تستقر عليه ووجدت السلطة التي تتولى شؤون الأمة وتنظم أمورها وقد وضع النبيe ميثاقا للمجتمع كان بمثابة دستور. يحفظ مصالح المجتمع والدولة وفق تعاليم الوحي الإلهي الذي ساوى بين أفراد المجتمع ، ولم يفرق بينهم في الحقوق والواجبات ، إلا بالتقوى وعلى قاعدة التقوى قام المجتمع الذي يدين بالولاء المطلق لله تعالى ، والطاعة لرسولهe فيما يأمر به ، وينهى عنه وشرعت مبادئ الحسبة في المجتمع الإسلامي من أجل تطبيق المبادئ الإسلامية في السلوك والأخلاق ، والمعاملات.
– العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي
تعريف الدولـــــــة: وقبل الشروع في العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي يستحسن ضبط وتحديد مصطلح الدولة في دائرة الفكر الإسلامي لتحديد ملامح الدولة الإسلامية، وأركانها الأساسية والفرق الجوهري بين الدولة الموسومة “بالإسلامية” عن غيرها . فالدولة عند علماء القانون الدستوري تتعدد تعريفاتها، حسب المعايير التي وضعوها لمفهوم الدولة ومنها على سبيل المثال أنّ الدولة هي :”مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة قاهرة “.
أو أنها : “جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة ، بينهم طبقة حاكمة ، وأخرى محكومة.”
أوانها: “جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين ، وتقوم فيهم سلطة حاكمة تتولى تنظيم شؤونهم وتدبير أمورهم في الداخل والخارج.”
ومن هذه التعريفات يمكن تحديد أركان الدولة المعاصرة بآلاتي :
أ-الإقليم وهو رقعة من الأرض التي يقوم عليها الشعب إقامة مستقرة ودائمة .
ب-الشعب أو الأمة المقيمة على هذه القطعة الجغرافية من الأرض .
ج-السلطة الحاكمة .
ويمكن القول إنّ هذه العناصر هي التي تشكلت منها الدولة الإسلامية منذ نشأتها في عهد رسول الله e – كما سبق بيانه – ولكنها اختلفت عن مفهوم الدولة الحديثة بإضافة ركن أساسي وهو تحكيم الإسلام في كل شؤونها ” فتوافر الأركان الأساسية للدولة في الفقه الدستوري المعاصر من شعب وإقليم وسلطة سياسية والتي بتوافرها يتحقق الركن المادي ، وإنما يتحتم لكي تعتبر الدولة “إسلامية ” أن يتوافر لها إلى جانب ذلك الكيان المادي كيان روحي تكون له الهيمنة التامة ، والمطلقة على الكيان المادي ، ويؤثر تأثيرا مباشرا في كل عنصر من عناصره وفي كل وضع من أوضاعه ، ويتمثل هذا الكيان في القواعد والمبادئ التي أوجبها الإسلام”.
ويتضح من هذا المفهوم الفرق بين الدولة الموسومة ب”الإسلامية” عن غيرها ، في القواعد والأحكام المتعلقة بعقيدتها وشريعتها الممثلة في الدستور الحاكم للمجتمع وبناء على هذا يمكن تعريف الدولة الإسلامية بأنها :” مجموعة من الأفراد – هم بحسب الغالب من المسلمين – يعيشون على رقعة من الأرض ويلتزمون التزاما حتميا وقطعيا بالقواعد والأحكام والضوابط الإلهية – في نطاق العقيدة والتشريع – المبينة في مصادرها التفصيلية ، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال وكفالة تحقيق ما أمر به الشارع.”
وبهذه الاعتبارات مع لواحقها تبدو خصوصية المفهوم الإسلامي للدولة وهو مفهوم تحقق أنموذجا واقعا معاشا لعدة قرون بدت خلالها قضية الحسبة كأنها العلامة الفارقة بين حياة مجتمعات تعيش في ظل دولة يضع أصولها الإسلام وبين مجتمعات تعيش في ظل دولة تتقلب بين تشريعات وضعية يبطل منها اليوم ما كان بالأمس ثابتا ويتحايل المواطنون من أجل الالتفاف عليها .
– مهام الدولة الإسلامية
إذا كان الهدف من قيام الدولة في المجتمع الإنساني إقامة العدل والحرية والمساواة، وفق قواعد سنتها البشرية عبر مراحل تطورها التاريخي ، فهذه المبادئ أقرتها دولة الإسلام منذ بعثة الرسول e “فكان الإسلام من مبدأ انبعاثه مقدرا له أن يكون نظاما سداه الدعوة إلى الحق والعدل ، ولحمته تنفيذ تلك الدعوة بأيدي المؤمنين. وأن لا يكتفي بظهور الحق ، الذي بعث به في حالة يكون الحق على من ينحرف عنه موكولا إلى قوة غير قوة ذلك الدين ، لأن الحقيقة الكاملة للدين أن ينقاد إليه أتباعه انقيادا كاملا.” وهذا بين في قوله تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور ِ ، فبيّن هذا الأصل القرآني أن غاية الدولة الإسلامية عند التمكين في الأرض هي إقامة شرع الله وفق منهجه ودستوره ، ومن دعائم هذا المنهج الإلهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا القانون يبنى عل تقاليد راسخة في التنظيم الاجتماعي وفي الإيجابية الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما من شك أن المجتمع الأمثل هو المجتمع الذي يقوم فيه الناس بأغلب شؤونهم ويتضاءل فيه دور السلطان لأضيق الحدود لأن السلطان يستعمل أدوات القهر والأحكام الظاهرية ، أمّا الدين – بجوهره – فهو موافق للوجدان وطاعة الله عزّ وجل يترتب عليها الجزاء الأخروي ، ولذا كلّما تدين المجتمع وأفراده من تلقاء أنفسهم دون أن يرهبهم سلطان الدولة ولكن رهبة الله تعالى ورغبة فيما عنده من مثوبة يقومون بأغلب وظائف الدين والدولة
والدولة في الإسلام وإن كانت مهمة وإقامتها واجبة على الأمة فهي ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتطبيق منهج الله المتكامل وفق مقتضيات كل عصر . ولم ترد في نصوص القرآن والسنة صورة تفصيلية لتطبيق المنهج الإسلامي على الدوام بوسائل معينة في شئون الحكم وتحقيق العدل” إنما جاء الإسلام في شؤون الحكم بمبادئ عامة تسمح عموميتها ، ومرونتها بالتطبيق في صور وأساليب مختلفة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان”. ، دون أن يكون انفصام بين الدين الذي يشكل الكيان الروحي ، والدولة التي تمثل الركن المادي ، وبهذا التوازن بين مصطلح الدنيوية والأخروية ، ورد التشريع كما يقول ابن تيمية : “كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر ، فالتعاون على جلب منافعهم ، والتناصر لدفع مضارهم ، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة ، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة أي لابد من وجود تشريع ضابط للمقاصد والمفاسد أمرا ونهيا وجميع بني آدم لابد لهم من طاعة آمرٍ وناهٍ ، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ،ولا من أهل دين ، فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم ، مصيبين تارة ومخطئين أخرى أما نحن المسلمين فإننا ندخل في طاعة الله ورسوله الذي يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر.”
ويرى الإمام الماوردي أن مهام الدولة وما يلزم سلطانها من وظائف تتمثل في جملة أمور تجب على سلطان الدولة ، ويلزم الأمة على أساسها الطاعة والانقياد وهي:
أولاً : حفظ الدين من التبديل فيه ، والحث على العمل به ، من غير إهمال له .
ثانياً : حراسة البيضة والذّب عن الأمة من عدوٍّ في الدين أوباغي نفس أومال.
ثالثاً: عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها.
رابعاً : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدِّين من أي تحريف في أخذها وإعطائها.
خامسا : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.
سادساً : إقامة الحدود على مستحقّها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها.
سابعا : اختيار خلفائه في الأمور أن يكون من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها.
وبناء على هذا يمكن القول بأنّ المهام والواجب المترتب على الدولة هي حمل الناس على تطبيق قواعد الشارع الحكيم في التزام كل طيب ، واجتناب كل خبيث ، وهو الهدف الذي يتوافق مع مبادئ التشريع وروحه ويحقق المصلحة الجماعية والفردية في قواعد العدالة الاجتماعية أمام القانون الذي كلفت الدولة بتطبيقه بصورة عادلة لأنّ “أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ، اكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم ولهذا قيل :إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام . وقد قال النبي e ” مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ” فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شئ ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.”
– خلاصة القول : أنّ مهام الدولة في الإسلام مثل دور الخادم للدين ، ومن هنا تترتب عليها أولويات قبل تطبيق قواعد الأحكام ، يجب عليها ترسيخ قيم الدين ومفاهيمه على أفرادها ومجتمعها ، ومن ثم يؤدى الأفراد دورهم كلّ حسب قدراته وإمكاناته في حماية القيم الروحية والمادية ، وبذلك يؤدون وظائف الدين ، ويحمون الدولة التي تشكل مع انتمائهم الروحي ، الركن المادي الذي وضع له الإسلام أطرا في قوالب القيم الدينية ، ورسم للمجتمع قواعد الحلال والحرام ، وهي كليات ثابتة لا تتغير مفاهيمها ، ولا يصبح ماكان حلالاً بالأمس حراماً اليوم ، ولا العكس يحدث ، بتشريع قوانين تحدثها ، من أجل مقاصد اجتماعية، أو اقتصادية ، ولربما حتى الثقافية التي يقرها الإسلام للشعوب التي تنتمي إليه ، فواجب الدولة الإسلامية هو أن تقوم سياستها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية … الخ على الأصول والمبادئ المقررة في الشرع الإلهي ومن ثمّ تحدد صورة العلاقة بين الأمة والدولة في المجتمع الإسلامي على أسس الشريعة وقواعدها.
وقد يلزم القول في هذا السياق من بيان العلاقة بين الأمة والدولة في ظل الإسلام بأن صفة الثيوقراطية أي الدولة الدينية وفق المفهوم الغربي غير واردة في الإطار الإسلامي لأن الجهاز الحاكم في المنظومة الإسلامية لا يتمتع بشيء من قداسة أو عصمة وبرهان ذلك أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيها استثناء حيث يكون ما يستوجبها بل تتأكد ضرورتها وفاعليتها ويتضاعف أجر القيام بها في دائرة من أوكلت إليه الأمة شؤون الحكم إذا تجاوز .
وبناء على هذه المفاهيم و بعد تعريف مفهوم الدولة الإسلامية ، والإشارة إلى أهمّ مهامها الوظيفية المتجددة والمتطورة بسير حركة المجتمع ونموه العمراني والبشري لعلي أحدد صورة من العلاقة بين الأمة والدولة في المفهوم الإسلامي من خلال ما رسمته الأصول والمبادئ الكلية للسياسة الشرعية – في علاقة الأمة بالدولة – في النظام الإسلامي وذلك في الآتي :
أولاً : وجوب التقيد بالشرع :
تبين مما سلف أن منطلق السيادة في الدولة الإسلامية هو الشرع الإلهي وقد جعل الله تعالى الخروج على مسار الشرع كفرا ،أو فسقا ،أو ظلما فقال تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وقال عزّ وجل : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وتعددت آراء العلماء في معنى الكفر الوارد في الآية وذكرواله تفسيرين هما كفر عمل ، وكفر اعتقاد والأول يترتب عليه إثم ولا يخرج بصاحبه عن الملة الإسلامية ، وأمّا كفر الاعتقاد فلا خلاف في خروج صاحبه عن الإسلام.و أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك قوله : ” هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.” وقد ذكر في تأويل الآيات أقوال مختلفة في كتب التفاسير ،رجح ابن جرير الطبري من بين جملة أقوال ذكرها قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ، ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى ، فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله ، جاحدا به هو بالله كافر ،كما قال ابن عباس ؛لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.” فوجوب التقيد بالشرع أمر لازم للدولة مع اعتبارات الأحوال ، والأزمان في تطبيقات الحدود ، كما هو لازم للأمة في أفرادها وجماعاتها ، لتعلقه بكمال الإيمان كما في قوله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً وفي هذا الأصل دلالة على أنّ من رد شيئا من أوامر الله تعالى أومن أوامر رسوله e فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. وكما في قوله تعالى إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ فالله تعالى يقرر في هذا النص القرآني إن الحكم لا يكون إلا لله وما على الحاكم والمحكوم إلا الخضوع التام لشرع الله ونهجه سواء تعلق بشريعة تعبدية أم بتوجيه أخلاقي،أو تعلق بشريعة قانونية وقد أشار الفقهاء إلى الجهة المنوط بها التأكد من تطبيق قواعد الشريعة – عند عجز المحتسبين والقضاة – وأطلقوا عليها قضاء المظالم وهي أعلى سلطة في تنفيذ الشرع وتتلخص مهامها في تنفيذ ما عجز عنه المحتسبون والقضاة في المصالح العامة .
فوجوب التقيد بالشرع في النظام الإسلامي يمثل فيه كل من القضاء والحسبة سلطة تنفيذ الشرع التي لا يفرق فيها بين الحاكم والمحكوم عند المخالفات الشرعية ، وفي رسالة عمر بن الخطاب t إلى أبى موسى أنموذج القضاء الإسلامي الذي تدور حوله صورة القضاء العادل يقول فيها : ” إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا استحللت القضاء عليه ، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى ،المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرى عليه شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء فإن الله سبحانه عفا عن الإيمان ودرأ بالبينات ، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام.” وفي هذا التوجيه العمري ما يحقق عمليا صورة التكامل بين غايات الحسبة ومقاصد النظام القضائي في حياة المجتمع الإسلامي حيث التآزر من أجل سد كل الثغرات التي قد يتسلل منها ظلم أو فساد أو تجاوز.
ثانياً: الشورى وخضوع الدولة لمحاسبة الأمة:-
من أهم قواعد العلاقة بين الأمة والدولة في النظام الإسلامي قاعدة الشورى التي تمثل الضمانة الحقيقية في إرساء قواعد العدل والأمن والمساواة واستقامة المجتمع ، وخضوعه للشريعة وطاعته للحاكم الشرعي العادل الملتزم الملزم بحدود الله , كما تمثل الأمة في الشورى الضمانة الدائمة في مراقبة الدولة . و الدولة هي الهيكل السياسي للحكم في الإسلام يشترك في تركيبها طرفان الحاكم والأمة ، والأمة هي التي تنصب الحاكم على قاعدة الشورى ، وهي التي تعزل الحاكم إذا خرج عن المشروعية الدستورية ولا يستثنى عن تنفيذ شرع من حيث خضوعه لقانون الشريعة والدستور الذي تضعه الأمة ومرجعيتها فيه الكتاب والسنة .
ومصطلح “الشورى” بمفهومه الإسلامي وبعده الحضاري” لا يقف أمامه ما يتغنى به الناس اليوم ويسمونه بالديمقراطية أو ما سيتغنون به في مستقبل الأيام من كلمات واصطلاحات لأنّ شحنة كلمة الشورى وابعادها حسب المعنى المراد منها لا تملكها أيّة كلمة أخرى ، ولا أيّ مصطلح من مصطلحات البشر لا يستند إلى هدى الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين . وذلك لأنّ كلماتهم الحاملة لما يريدونه من معان ومصطلحات تشريعية لا تخلو من مرامي هواهم ، ومن أهداف شهواتهم ، والحق لا يتبع هواهم ولا يستجيب لشهواتهم.” كما قال الله تعالى : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ،فالشورى تمثل الضمانة الحقيقية لتطبيق المنهج الإسلامي المتكامل الذي يعطي أكبر مساحة للمساهمة الجماعية وللمشاركة فيما هو حق وعدل في سياسة الأمة ، ومن ثمّ فإن الأمة تكون قادرة على رقابة الدولة بموجب التكليف القرآني الوارد في قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فعلى الأمة تقع مسؤولية رقابة الشريعة ورقابة الانحراف في سلوك المجتمع الظاهر فتحتسب على المنكرات بشتى الوسائل المشروعة والمقدور عليها وقد أعطى الشرع مساحة واسعة لإثبات القيم الإسلامية وحصر دوائر الشر والمخالفات ،فقالe :” مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الأِيمَانِ” وبهذا المفهوم يصبح كل فرد من أفراد المجتمع رقيبا على الدولة في حدود ما له علم به لأنّه جزء لا يتجزأ من الأمة .
وبما أن الدولة الإسلامية تهدف إلي إصلاح الإنسان روحيا وماديا وقطع دابر الفساد بإقامة شرع الله وفق ما رسمته من السياسة الشرعية فإن ذلك لا يتأتى للدولة إلا بأمرين:
أولهما : إصلاح الفرد ، وذلك بإصلاح عقيدته وتصوراته وأفكاره وقيمه وأخلاقه وموازينه كلها وفق منهج الله ؛لأنّ أساسيات الدين الإسلامي اعتقاد الحق وإقامة البرهان على المعتقد ، وتعميم المعاملات والإخاء ، وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الشريعة بحيث تحفظ الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية.
ثانيهما : إصلاح المجتمع الإنساني بإصلاح علاقاته ونظمه وقوانينه طبق أصول الشريعة وضوابطها .
وإذا تحقق هذا وجب على الأمة طاعة الدولة التي تعد من أهم أهداف الإسلام التي أمر بها الله تعالى المؤمنين في قوله} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
يقول الإمام الشوكاني في بيان الآية “لما أمر سبحانه وتعالى القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق أمر الناس بطاعتهم هاهنا وطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله فيما أمر به ونهي عنه ،وأولوا الأمر :هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية”.
فطاعة الله واجبة على الأمة وطاعة رسول الله من طاعة الله ولكن طاعة أولي الأمر رهينة بأمرين :-
أولهما : أن يكون أولو الأمر من جماعة المسلمين منكم .
ثانيهما : طاعة أولي الأمر رهينة بطاعة الله ورسوله ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أكد ذلك النبي e في حديثه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي e قال : ” عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ” وقد يتبين ذلك في تجربة الحسبة في النظام الإسلامي في ثنايا البحث .ويبد ومن خلال السياق القرآني الذي يرد فيه لفظ الشورى أن الخطاب القرآني يتوجه إلى الأمة وإلى النظام الحاكم بإرادتها هي . ومؤسسة الشورى يميزها عن الديمقراطية بكل صورها وتطبيقاتها أن الشورى إلزام قرآني تشريعي دستوري داخل في مفهوم كمال الإيمان ومحقق لإحدى خصوصيات الأمة في النظام الإسلامي وإذا تخلفت الأمة عن تحقيق هذا المقصد القرآني الإيماني التشريعي الحياتي فإن نظام الحسبة والقائمين عليه معنيون بمعالجة هذا التجاوز وفقا لضوابط الاحتساب .
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=22152


















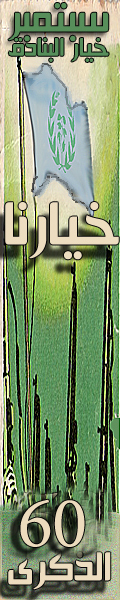
أحدث النعليقات