نظرية الحسبة في النظام الإسلامي أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية
الحلقة الثالثة
إدريس محمد عثمان
النظام الإسـلامى مفهومه وخصوصياته
تعريف النظام لغة واصطلاحاً: يطلق النظام في اللغة على ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره . وكل شعبة وأصل منه نظام ونظام كل أمر ملاكه والجمع أنظمة ونظم يقال ليس لأمرهم نظام أي ليس لأمرهم هدى ولا متعلق يتعلق به.
وعند الفقهاء النظام هو : “مجموعة الأوامر والنواهي والإرشادات التي تحدد الطريقة التي يجب اتباعها في تصرف معين ومنه النظام الاقتصادي والنظام الإداري…”
وعرّف النظام بأنه : “مجموعة الأحكام التي اصطلح شعب ما على أنها واجبة الاحترام وواجبة التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة لهذا الشعب .” وهذا التعريف يحدد الإطار الذي يجب التزامه ، في دائرة مجتمع ما لما يصدر عنه من قرارات هي بمثابة قوانين قابلة للتغيير بحسب التطور الزمني من جهة ، وبحسب رغبات وميول المجتمع من جهة أخرى ويطلق مصطلح النظام العام على ” الأساس السياسي ، والاجتماعي ، والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان المجتمع في الدولة ، كما ترسمه القوانين المطبقة فيها وكل اتفاق يخالف النظام العام يكون باطلا مطلقا .” وربما يكون هذا المصطلح اقرب إلي الشمولية إلا أن القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن القواعد التي تقوم عليها كل الأنظمة البشرية ، فالنظام الإسلامي يقوم على أساس أن الله وحده هو الذي يشرع للبشرية ، وسائر الأنظمة الوضعية تقوم على أساس أن الشعب هو الذي يشرع لنفسه وهما قاعدتان لا تلتقيان ومن ثم فالنظام الإسلامي لا يلتقي مع أي نظام من حيث المصدر التشريعي ، ولا يجوز وصفه بغير صفة الإسلام وبناء على هذا يأتي التساؤل الآتي :ما هو مفهوم النظام الإسلامي ؟ وما هي خصوصياته؟
فمـفهــوم النظام الإسلامي هو مجموعة الأصول والمبادئ الكلية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية في تنظيم شئون الحكم ، وهي الأصول والمبادئ التي طبقت في صدر الإسلام تطبيقا واقعيا مستقيما في ضوء ظروف البيئة ومقتضيات العصر . وذهب بعض العلماء إلى القول: بأن الدين في المفهوم الإسلامي هو المرادف لكلمة نظام في الاصطلاحات الحديثة مع شمول المدلول للعقيدة في الضمير ، والخلق في السلوك ، والشريعة في المجتمع فكلها داخلة في مفهوم “الدين “في الإسلام . ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك نظام يقبله الله ، ويقره الإسلام ما لم يكن هذا النظام مستمدا من الشريعة الإسلامية دون سواها ، وأهم من هذا كله أن يذعن أصحاب هذا النظام لألوهية الله وربو بيته فلا يدعون لأنفسهم حق إصدار الشرائع ، والأنظمة وهنا يفترق النظام الإسلامي عن كل النظم البشرية.
ومن المفهومين السابقين يمكن القول : بأن الغايات ، والأهداف التي يرسمها النظام الإسلامي للحياة الإنسانية تنسجم مع الغاية التي خلق الإنسان من أجلها كما في قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ والعبادة تقتضي الطاعة المطلقة لله تعالى ، فيما شرع من أحكام وتشريعات أحاطت أحكامها بأفعال العباد من حيث بيان ما يحل من الأمور ، وما يحرم وما هو مندوب وما هو مكروه ثم ما هو مباح ، كما يقول ابن حزم : ” الشريعة كلها إمّا فرض يعصي من تركه ، وإمّا حرام يعصي من فعله ، وإمّا مباح لا يعصي من فعله ، ولا من تركه ، وهذا المباح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إمّا مندوب إليه يؤجر من فعله ، ولا يعصي من تركه ، وإمّا مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله ، وإمّا مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من تركه.” وفي دائرة المباح هذه يمكن سن القوانين ، الملائمة للزمن في الأمور التي يشملها التغيّر الزمني كالشئون المتعلقة بشكل الحكومة ، أو الفنون الصناعية أو القوانين الاقتصادية…الخ والشريعة كي لا تقف حجر عثرة في سبيل التقدم الإنساني لا تنص على أحكام مسهبة ، ولكنها تكتفي إمّا بإرساء قواعد عامة فحسب ، أو تصمت إزاءها كل الصمت فلا تسن أي تشريع ، وهذا هو الموضع الذي يجوز ، وينبغي لنا أن نجتهد فيه.
وفي نظام الحكم لم يقرر القرآن الكريم شكلا معينا يجب أن تكون عليه الحكومة الإسلامية ولم ينص على كيفية سلطاتها وإنما قرر الأسس والقواعد ،الثابتة التي يجب أن يقوم عليها النظام منها : قاعدة العدل كما في قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً وهو عدل شامل لامحاباة فيه ولا يفرق بين بني البشر كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، ويقول النبي : e: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ.”
ومن أهمّ القواعد التي يبنى عليها النظام الإسلامي قاعدة الشورى ، وهي مفروضة على نظام الأمة في جميع عصورها لقوله تعــالى : والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أمّا كيفية تطبيقها ، وأساليب العمل بها من حيث الشكل فمتروك للمسلمين كل حسب بيئاتهم ، ومقتضيات عصرهم ، وعلى قاعدة الشورى في الحكم والعدل والمساواة في التطبيق قدمت الشريعة تفصيلات كثيرة عن أصول النظم الإسلامية المتعددة ” من نظام روحي عبادي ، إلي نظام اجتماعي متوازن ، ومن نظام سياسي شورى ، إلى نظام اقتصادي جماعي ومن نظام لأوضاع السلم إلى نظام لظروف الحرب ، ومن نظام خاص بضبط علاقات المسلمين ببعضهم ، إلى نظام عام يحدد العلاقات بينهم وبين الأمم الأخرى ، ومن نظام دستوري كلى إلى نظام قانوني تفصيلي.”
خلاصة القول : أن مفهوم النظام الإسلامي يشمل الحياة الروحية والمادية ، الفردية والجماعية وقد رسمت الشريعة من الأصول ، والقواعد ، والضوابط ، ما هو كفيل بحل المشكلات المتجددة في الحياة الإنسانية بالأصول الثابتة ، والقواعد المرنة ، وسيتضح في بيان خصوصيات النظام الإسلامي ما يميزه عن النظم الوضعية .
خصـوصيـات النـظـام الإسلامي:خصوصيات النظام الإسلامي في أحكامه ، هي نفسها خصوصيات الشرعة المستخلصة من الأدلة الكلية والتفصيلية للشريعة ، وقد استقرأ العلماء نصوص الكتاب والسنة ، ونظروا في مقاصد الشريعة ، فحصر بعضهم خصائصها في عشر وهي : الشمول لكل جوانب الحياة ، والتكامل ، والصفة الدينية ، والأصالة والاستقلال والمرونة ، وأنها مثالية وواقعية في نفس الوقت ، والتوافق مع الفطرة ، وحتمية تحقيقها للمصالح الإنسانية ، وابتناؤها على ثنائية المسئولية ، وثنائية الجزاء ، وصفة العموم في الزمان والمكان. وسأقتصر على بعض هذه الخصوصيات في سياق الحسبة موضوع البحث.
أولاً : خـاصية المصدر التـشريعـي :-
إن من أهمّ خصائص النظام الإسلامي ، أنه مؤسس على الوحي ، كتابا ، وسنة ومنهما يستمد أحكامه في المرجعية التشريعية ،والتنفيذية وعلى هذه الخاصية ” ربانية المصدر ” جاء كمال التشريع في الأصول الكلية والقواعد الأساسية ، وعن كمال هذا المصدر التشريعي يقول الله تعالى : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ويقول تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً ، فكمال الدين يعني كمال أصول العقيدة والشريعة والعبادات ، وأصول المعاملات ، وفي كمال هذه الأصول ما يؤكد عدم النقصان كما قال تعالى : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وفي كمال الشريعة ما يؤكد خلوها من النقائص والنقائض ، والظلم ، والهوى ، والمحاباة ، والنسيان ، والباطل ، ونحو ذلك من الصفات التي لا يستطيع البشر في أنظمتهم الوضعية ، أن ينجوا أو يخلصوا منها حين يستقلون بتشريعاتهم بمعزل عن هدى الوحي فبخصوصية المصدر التشريعي ، يتسم النظام الإسلامي بميزات جوهرية ، تميزه عن النظم ، والقوانين الوضعية ، كالكمال والسمو ، والدوام ، وثبات الأصول وقابلية التطور لضبط المتجدد من الجزئيات تحت المفاهيم الكلية .
والشريعة بحكم مصدرها استكملت كل ما تحتاجه من قواعد ومبادئ ، وأنها غنية بالمبادئ التي تكفل سد حاجة الجماعة ، في الحاضر القريب ، والمستقبل البعيد ، وفي سموها عن القوانين الوضعية تمتاز بقواعد ومبادئ هي أسمى ما تنظم به الجماعة ، وفيها من المبادئ ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة لأنها ثابتة ومستقرة ، وغير قابلة للتعديل والتبديل في أصولها وقواعدها.
ثانياً : خـاصــيــة الشــمـولـيـــة:-
خاصية النظام الإسلامي في شموليته التي لا تقبل التجزئة مبنية على المصدر المستقى منه– الكتاب والسنة – اللذين استوعبت ” أحكامهما الحياة كلها والزمن كله ، ورسالة الإسلام امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى انتظمت في آفاقها الأمم وامتدت عمقا حتى استوعبت شئون الدنيا والآخرة”.
وتعد الشمولية من أهمّ خصائص نظم الإسلام وتشريعاته ؛ لأن الحياة في المنظور الإسلامي عبارة عن وحدة مؤلفة من عناصر متداخلة ، في جوانبها الروحية والمادية ، فالجانب الروحي لا يقل خطره عن الجانب المادي ، وأدب النفس لا يقل عن أدب الجماعة ، والمعاملات تعتمد على أسس أخلاقية ، اعتماد العبادات على أسس روحية ، وللفرد ما للجماعة من حقوق والفضائل جميعها متساوية في الاتباع ، لا تغني واحدة عن الأخرى ، وفي خاصية الشمول هذه يدعو النظام الإسلامي إلي إقامة مجتمع فاضل مشترك في السراء والضراء ، متعاون على البر والتقوى ، آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكرات كلها. ،وبهذه الصورة المتماسكة في قاعدة البناء الروحي والمادي تشكل حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة ويقوم على أسسها النظام الشامل في الأمة.
وخاصية الشمولية الإسلامية تقوم على نهج الشمول الموضوعي ،والزماني ،والمكاني وقد نسق الإسلام نظامه ” بين الروحيات والزمانيان وبين العقيدة والتشريع ،وبين العبادات ،والمعاملات ” ولا تنحصر أحكامه في زمان أو مكان ، فهي شاملة للبعد الزماني والمكاني ، كما في قوله تعالى : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وقوله تعالى تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً{
ثالثاً : خـاصــيـــة الثبـات والمــرونـــــة :-
تتجلى خاصية الثبات في النظام الإسلامي في أصول العقائد والعبادات والقيم الأخلاقية والمرونة في فروع أحكامه ، الاجتهادية المبنية على أصولها الشرعية، ولهذا قرر علماء الشريعة باستقراء أدلة الأحكام ، والقرائن والأمارات الشرعية ، إلى تقرير صفة الثبات ، والقطع ، والمرونة والتغيير فقال ابن القيم : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه اجتهاد يخالف ما وضع عليه .والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ، ومكانا ، وحالا ، كمقادير التعزيزات ، وأجناسها وصفاتها ، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة .”
فالثبات والقطع في أصول العقائد ، والعبادات وأصول المعاملات ، والمرونة في المجالات الاجتهادية ، التي تتغير بتغير الأزمان والأحوال لتحقيق المصالح الإنسانية وهو من اعظم مقاصد الشريعة فالفروع الفقهية التي تدخل في بناء أنظمة الإسلام تتجدد بتجدد المصالح البشرية ؛ لأن منشأ ذلك جملة أمور منها :
أ – مرونة مصادر التشريع التبعية ، كالإجماع والقياس والمصلحة المرسلة ، وغيرها من المصادر التي تقدم حلولا لكل الوقائع والقضايا ، والنوازل والتصرفات ، والانحرافات الدينية ، والدنيوية.
ب – نص الكتاب والسنة في الميادين التي تخضع للتطور بطبيعتها على المبادئ العامة وترك الجزئيات والتفصيلات والتفريعات ، للاجتهاد الفقهي الملائم للواقع الزماني والمكاني .
ج – المرونة في جواز تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان ، والأحوال والمصالح وجمهور العلماء يجعلون إمكانية هذا التغير في الأحكام بتغير الأزمان شاملا لكل ما لم يرد به نص في الكتاب أو السنة ولا في إجماع صحيح.
رابعاً : خـاصية ثنائية المسـؤوليــة :-
يقرر النظام الإسلامي مبدأ ثنائية المسئولية ، الذي يتمثل في أن المجتمع أفرادا وسلطة ، يجدون أنفسهم في النظام الإسلامي أمام مسئوليتين ، وكل مسلم سواء أكان فردا أم كان ضمن السلطة الحاكمة مسؤول عن تنفيذ الشرع الإسلامي بما يتضمن من أحكام حقوق الله ، وحقوق العباد على نفسه أولا وحمل غيره على تنفيذ الشرع ثانيا.
وبناء على مبدأ ثنائية المسؤولية تقررت الحسبة في النظام الإسلامي وتقررت الأصول الشرعية لهذا النظام منذ بدء تكوين المجتمع الإسلامي الأول ، لحماية القيم الدينية والأخلاقية ،وتوجيه المجتمع توجيها عقديا وفكريا وسلوكيا ، يكون في ذلك كله ولاؤه لله وطاعته لأوامره في تنفيذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى :} وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ فالأمر بالمعروف المقرر في الشرع مسئولية ثنائية بين المؤمنين والنهي عن المنكر كذلك ، وبهذه الخصوصية رسم النظام الإسلامي منهجه في ضبط القيم وحماية الحقوق كلها، إذ جعل كل فرد في المجتمع قواما على مراقبة تنفيذ الشرع ، حارسا لمبدأ المشروعية ، مسهما في إرساء مبادئ القواعد الشرعية كما في قول رسول الله e” أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ،وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.” وبهذه المسئولية الثنائية ،يعتمد النظام الإسلامي في نقل أحكامه من النظرية إلى التطبيق ؛لأن مسئولية التكليف الفردي والجماعي مسئولية إلزامية متبادلة بحيث تجعل رقابة المجتمع في أقصى درجاتها من تنفيذ الشرع ، والتزام الأوامر واجتناب النواهي .
خامساً : خـاصـيـة ثنائية الجــزاء :-
إذا كان من خصائص القانون الوضعي أن يكون مقترنا بجزاء توقعه الدولة عند الاقتدار على من يخرج على أحكامها ، فإن الشريعة تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف ، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها أخروي ودنيوي بل إن الأصل في أجزيتها هو الجزاء الأخروي ، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع ، وتنظيم علاقات الأفراد وضمان الحقوق كل ذلك استدعى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي،فقال تعالى :} إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم ٌ { فالنظام الإسلامي لكي يضمن عدم الخروج عليه يقرر لكل قاعدة جزاءين جزاء دنيويا يتمثل في العقوبات الشرعية المقدرة ، أو التعزيرية وهي عقوبة باجتهاد الحاكم إذ ليس لها في الشرع حد معروف أو كفارة ، بالرغم من أن الفقهاء اجتهدوا ، وحددوا للمحتسب عقوبات ، معدودة…وفسحواله في مجال الاجتهاد والتدبير في الأخذ بما يراه مناسبا ، حسب درجة المخالفة ، ومبلغ خطرها ، ابتداء من التأديب والزجر إلى الجلد والحبس والنفي أو العقوبة المالية.
أمّا الجزاء الأخروي فيترتب على كل مخالف لأحكام الشريعة ، سواء أكانت المخالفة من أعمال القلوب ، أم من أعمال الجوارح ، وسواء أكانت من مسائل المعاملات المالية أم مسائل الجنايات سواء عوقب عليها في الدنيا أم لم يعاقب ، مالم تقترن مخالفته بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير ، وهنا يظهر الفرق الجوهري ، بين تشريعات الإسلام ، والتشريعات الوضعية ، في ترتيب إيقاع العقوبات “وتسود كل قوانين الشريعة ونظمها خاصية ثنائية الجزاء في الوقت الذي لا يتيسر فيه للقوانين البشرية إلا جزاء وحدا ، ويتعذر عليها بسبب وضعها التشريعي أن تواعد الناس بجزاء في الآخرة سواء أكان ثوابا أم عقابا. ”
سادساً : خـاصية الأصـالة والاستقلال :-
خاصية الأصالة والاستقلال في النظم الإسلامية ترجع إلى الخاصية الأولى وهي المصدر التشريعي كتابا وسنة ، ومن هاذين المصدرين نشأت أنظمة الإسلام ثم تنامت وتوسعت فروعها بطريق الاجتهاد الفقهي حتى تناولت كل قضايا الحياة في إطار قواعد الشريعة وأصول الاجتهاد ، التي لها أصول في الشريعة نفسها لاستنباط الأحكام للوقائع المتجددة في الحياة ، كالإجماع ، والقياس والمصلحة ، وغيرها من المصادر التبعية ، وهذه أيضا لامدخل فيها للأهواء ، بل هي مناهج معلومة وقواعد مرسومة توصل إلى معرفة حكم الله ، أو مظنة حكم الله تعالى في المسائل بطريق الاجتهاد.
وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية التي تبين استقلالية أصول النظام الإسلامي ، وقواعده كقوله تعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ وقوله تعالى:} فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فهذه النصوص وغيرها تبيّن وجوب اتباع منهج الشريعة دون غيره ، وهو منهج كامل في أصوله وشامل في فروعه وقابل لاستيعاب المستجدات من الأمور الحياتية الطارئة على نمو المجتمع وتطوره ، وهو مستقل بذاته في أصوله الشرعية ، وقواعده التطبيقية ، ويأتي بيان ذلك ضمن مباحث الفصل القادم .
خلاصة القول: أن مبادئ النظم الإسلامية بحكم مصدرها التشريعي لها غاياتها من التطبيق وهي التعبد إرضاء لله تعالى واحتساب الأجر عنده ، وهذه الغاية لاوجود لها في القوانين الوضعية ،كما أن أصول النظام الإسلامي وقواعده واجبة وإلزامية لقوله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا
وهذا الوجوب مفقود في القوانين الوضعية لما يترتب عليه من ثواب وعقاب . وكذلك فإنّ ابتناء القواعد الشرعية في النظام الإسلامي على ثنائية الجزاء وثنائية المسؤولية يجعل إمكانية نقلها من النظرية إلى التطبيق ، ومن المخالفة إلى الالتزام ، إما خوفا من العقوبات الدنيوية العاجلة ، أو العقوبات الأخروية الآجلة . وقد تتضح بعض الخصوصيات الأخرى في بيان مجالات الحسبة وتطبيقاتها.
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=22274


















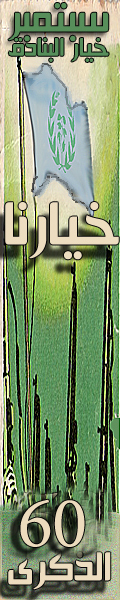
أحدث النعليقات