لماذا ندعو الى سلطة سيادية منفصلة عن السلطة السياسية (3)
وظائف الجمعية التأسيسية
تضطلع الجمعية التأسيسية بحسب النصوص التي سنضعها في الدستور والنظام الداخلي للجمعية التأسيسية بثلاثة وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية ووظيفة المؤسس حيث تحدثنا في المقال السابق عن الوظيفة التشريعية والرقابية وتبقى لدينا الحديث عن وظيفة المؤسس.
ثالثاً : وظيفة المؤسس
هي وظيفة إعتبارية هامة مخصصة لصاحب المؤسسة ليتميز عن غيره من الشخصيات الإعتبارية وينفرد عنهم بموقع الصدارة والأستاذية وذلك من خلال الآتي :
رفع مقام الشعب ونقله من العدم الى الوجود ومن فراغ جعبته من الصلاحيات الى مالك للصلاحيات ومصدر السلطات بصورة واقعية لا هتافية وإحتفالية تنتهجها الحكومة في كل مناسبة وطنية رسمية وشعبية وتنتهي بإنتهاء المناسبة ، ومن خلال هذه الوظيفة أصبح مالك المؤسسة (الشعب) هو المدير الفعلي لشئونه العامة وهو المتحكم في مصلحته وصدور قراره بنفسه بعيداً عن الوصايا والتهميش المعتمدة في نظام الدمج المتعمد للوظيف السيادية والسياسية .
تمليك الشعب بطاقة عضوية في المؤتمرات الفرعية للحي والقرية والمنطقة والإقليم إثبات بالممارسة على أنه أصبح كيان تنظيمي و تعبير صارخ عن إعتراف الدولة بهذا الكيان ، يجعل مهام وصلاحيات الدولة الفارغ من آليات تفعيل المشاركة الجماهيرية يمتلئ بمهام وصلاحيات الشعب التنظيمية ، ويمنح الجماهير الإحساس بأن الدولة أصبحت ملكاً لهم ولم تعد مغتصبة من قبل النائب .
كل مواطن مستقل عن الأحزاب السياسية يملك حق تداول إدارة المؤتمرات المفتوحة حسب القرعة الإنتخابية داخل كل دائرة، لأن المؤتمر كيان مستقل عن نفوذ الحكومة وله صلاحيات نقل موجهات وتوصيات وقرارات جماهير كل دائرة جغرافية على حدى بصورة مستقلة عن النظام الإداري الحكومي ، بحيث تتجمع هذه الأوراق وتتصعد حسب التسلسل الإداري المعروف (الحي ثم المحلية ثم المنطقة ثم الإقليم ) ، وينتهي مطافها بتسليمها لنواب الشعب المنتخبين من داخل المؤتمر التأسيسي المفتوح (على مستوى القطر) للقيام بأدوار المؤسس داخل البرلمان الإرتري عبر إنتماءهم للجمعية التأسيسية المستقلة والتي تمثل الشق السيادي للبرلمان الى جانب الشق السياسي والمتمثل في الجمعية التشريعية.
للشعب ايضاً موظفين يمارسون دور المؤسس نيابةً عنه عبر إدارتهم لمكاتب الرقابة الدستورية في جميع فروع مؤسسات الدولة ومستوياتها التنظيمية والجغرافية المختلفة، بالإضافة الى دور المفوض البرلماني (الإمبودس مان) الذي يمارس الأدوار التالية :
للمفوض البرلماني حق اقامة الدعوى أمام المحاكم المختصة ضد من ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون بسبب التحيز او المحسوبية او أي سبب آخر أو أهملوا في تأدية واجباتهم على النحو المطلوب . وعلى هذا الأساس يمارس المفوض اختصاصه في ثلاث مجالات هي :
1. الرقابة الادارية :
للمفوض البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفسه او بناء على شكوى يتلقاها من الأفراد (مواطنيين)، او بأي وسيلة أخرى يعلم من خلالها بوقوع مخالفة، كحقه في إجراء التفتيش الدوري على المؤسسات الإدارية وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على المستندات والملفات وله حق استدعاء أي موظف ويستجوبه فيما ينسب اليه ، وله اقامة الدعوى على الموظفين المقصرين في اداء واجباتهم ومطالبتهم بالتعويض لمن لحقه ضرر من جراء التصرف غير الشرعي للادارة. كما يتمتع بصلاحية توجيه الادارة الى وجوب اتباع اسلوب معين في عملها تتدارك فيه خطأها ولو لم يكن منصوص علية في القانون الا انه يرى فيه تطبيقا لمبادئ العدالة فيه وروح القانون وضمانا لمصلحا الفرد من جهة والمصلحة العامة ممثلة بالادارة من جهة اخرى .
وبالنظر الى المثال السويدي في تحديد اختصاص المفوض البرلماني (الإمبودس مان) في هذا المجال شاملاً إلاَّ فيما يتعلق برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية فهو مصون أما الوزراء فينحصر اختصاصه في تحريك الدعوى بحقهم أما مسائلتهم فهي من شأن البرلمان وحده كما يخرج عن اختصاصاته أعضاء البرلمان والمواطنين العاديين.
2. الرقابة على جهاز القضاء :
يختص المفوض البرلماني وفقا للدستور بالرقابة على القضاء وتطبيقهم لوظائفهم ومسائلتهم عن اخطائهم التي يقعون فيها اثناء تنفيذهم لاعمالهم فيما يخص تأخير حسم الدعاوى او عدم محافظتهم على المستندات والسجلات وسوء تنفيذهم للاحكام او اخلالهم بالسلوك الواجب اتباعه في الجلسة او خارج المحكمة، كما يسأل الامبودسمان القضاة عن الاحكام الصادرة خلافا للقانون اذا كان الاخلال بحسن نية او كان الخطأ مقصود ، وله الحق في إجراء التحقيقات والالتقاء بالمتهمين والتأكد من عدم مرور وقت طويل على توقيفهم قبل محاكمتهم وذلك من خلال زيارة المحاكم ومكاتب الادعاء العام .
ومن الدول التي أخذت بالرقابة على القضاء وجعلته من ضمن اختصاصات المفوض البرلماني فنلندا والدنمارك اما فرنسا ونيوزلندا والنروج والمملكة المتحدة والكثير من الدول الاخرى التي تاخذ بهذا النظام فانها لا تجيز هذا النوع من الرقابة على اساس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتقاليد والمبادئ الدستورية التي تحمي هذا الجهاز المهم وترفض اي تاثير خارجي عليه . الا أننا لانجد في ممارسة هذه الرقابة خروجا على مبدا استقلال القضاء ، فرقابة المفوض (الإمبودس مان) لاتساهم في اصدار الاحكام ولا تغير في مضمون قناعة القاضي واستقلاليته في اصدار قراراته ، وغاية ما في الأمر هو الاشراف على الجانب الإداري من عمل القاضي كمدة تأجيله للدعاوى وفترة حسمها وأسلوب إدارته للجلسات والتزامه بقواعد المرافعات
الا اذا تعلق الأمر بمخالفة جسيمة للقانون وفي هذه الحالة لا يشكل الأمر خرقا للاستقلال بقدر ما يحقق الصالح العام .
3. الرقابة على القوات المسلحة :
يتميز المفوض البرلماني في السويد بمراقبة القوات المسلحة ويهدف من ذلك الرقابة على الادارة العسكرية وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة ، وله في ذلك مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالجيش ومراقبة الادارة الاقتصادية العسكرية واجهزة الرقابة الداخلية العسكرية كما يتعرض لمختلف الاخطاء التي تخل بحسن ادارة مرفق الدفاع الوطني .
وهو في ذلك يتمتع به الامبودسمان المدني من حق تلقي الشكوى واجراء التفتيش الدوري ، وقد لاقى هذا الاختصاص الرقابي للإمبودس مان على القوات المسلحة الترحيب من الكثير من الدول التي اخذت بهذا النظام فأخذت به فنلندا والدنمارك والنرويج ، حتى أن عمل المفوض (الإمبودس مان) الالماني(wehrbe faen ftrgg) اقتصر على الشؤون العسكرية .
بينما امتنعت بعض الدول عن الاخذ بالرقابة على الأمور العسكرية وقصرت إختصاصات المفوض البرلماني على الإدارة المدنية فيها ومنها المملكة المتحدة وفرنسا والهند وبعض الدول الاخرى .
أهم مميزات النظام البرلماني لدى العقلية الغربية :
1. يخلق تكاملاً حقيقيًا بين السلطات الثلاث لأنهم غالبا ما ينتمون إلى تيار سياسي واحد فلا يختلفون في أغلب الأحوال وذلك في حال حصول حزب ما على الأغلبية.
2. حكم الجماعة ( البرلمان ) يعزز الديمقراطية ويقلل الاستبداد الذي قد ينتج عن تمركز السلطات كلها في يد شخص واحد مثل رئيس الجمهورية.
3 . البرلمان قوة هائلة ، فيصعب التهرب من المحاسبة البرلمانية لأي مسؤول يخطئ ، وتتم جلسات أسبوعية لمناقشة جميع الوزراء ومحاسبتهم .
4. رئيس الوزراء فعليًا متساو مع الوزراء الآخرين ، والكل تحت مظلة البرلمان ، فلا سلطات مطلقة في يده.
5. سرعة اتخاذ القرارت استجابة للمتغيرات المحيطة ، كما يشجع النظام على وجود حوار سياسي دائم بين كل القوى السياسية في المجتمع.
عيوب النظام البرلماني والحل الإرتري المقترح لمعالجتها :
1. في الدول النامية تطبيق هذا النظام يؤدي إلى عدم استقرار الحكومة ، نتيجة للخلافات الدائمة بين الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم وعدم استقرار الحكومة نتيجة إقالتها باستمرار ، ولهذا رأينا ضرورة دعم البرلمان بآلية مستقرة تمثل الشعب وتقوم بوظيفته كمؤسس .
2. صعوبة الحصول على دعم قوي للحكومة من البرلمان في ظل وجود اتجاهات حزبية مختلفة ومتضاربة المصالح، وقد تخضع الحكومة لمجموعة برلمانية محددة وتتجاهل الآخرين ، وقد يؤدي الولاء للحزب صاحب الأغلبية إلى توقف بعض النواب عن نقد أداء الحكومة التي تمثل حزبهم ، ولمعالجة هذا الخلل كان إنتماء النائب في الجمعية التأسيسية للشعب وحده لا إنتماء له بكيان آخر له مصالح متعارضة.
3. الانصهار بين السلطات الثلاث قد يؤدي إلى فساد السلطة والاستبداد بها خصوصًا في الدول النامية التي تفتقد لمؤسسات قوية تابعة للشعب ومستقلة عن الأحزاب السياسية .
4. موعد الانتخابات غير ثابت ، مع ما يعنيه هذا من وقت وجهد ومال ، بالإضافة الى بروز حق رئيس الوزراء البقاء في منصبه حتى انتهاء الدورة البرلمانية ما دام يملك الأغلبية البرلمانية ، ومن حقه أن يدعو لانتخابات جديدة متى رغب في ذلك للحصول على المزيد من المقاعد البرلمانية لحزبه أو لإنقاذ حكومته من سحب الثقة
، الأمر الذي مثل عقبة كأداء أمام إنتقال السلطة ببساطة من يده الى أيدي أخرى بصورة ديمقراطية ، ومن ثم يأتي مقترح الديمقراطية البديلة لإنتخاب برلمان من نوع آخر تنفصل فيه السلطة السيادية عن السياسية ، وتغيب معه مبررات إقامة إنتخابات عامة وإهدار نفقات باهظة من خزينة الدولة لإرضاء غرور الحكام .
5. رئيس الوزراء ( الحاكم الفعلي ) لا يتم انتخابه مباشرة من خلال شعبه، ولا تتم محاسبته إلا من خلال البرلمان الذي اختار الشعب أعضاءه ، وهي كما نرى وسيلة مريحة تحمي الحاكم وتحفظ ماء وجهه وتبعد عنه شبح بروز عيوبه وأخطاءه للمجتمع حيث يتم دفنها داخل الوسط الذي ينتمي له بعيداً عن رقابة الشعب ومحاسبته ، مما دعانا الى البحث عن وسيلة أخرى رادعة تحقق لنظام الحكم نسبة معقولة ومرضية من الشفافية والمحاسبة من خلال بناء شبكة قوية من المكاتب الإدارية للرقابة الدستورية تعمل تحت إشراف وتوجيه الجمعية التأسيسية ومنتشرة كالشريان والأوردة في فروع ومستيات الحكم الرئاسي والوزاري والمحلي ، وبذلك وحده يتجاوز العالم الثالث مرحلة إهدار قيم الديمقراطية خلف أقنعة الحكم الزائف المتدثر خلف شعار الديمقراطية .
6. أثبت هذا النظام (التقليدي للبرلمان) عدم فعاليته في الشعوب ذات التجربة الإنسانية العميقة المرتبطة بجزور أخلاقية تاريخية نابتة عن قيم الأديان السماوية المقدسة لديها والتي لا تشعر بإنفصام في العلاقة بين الدين والسلطة وبين العلم الأرضي والسماوي طالما أن القيم الإنسانية هي التي ستحكم سلوك الحاكم والمحكوم، فتحقيق النظام البرلماني في هذه الشعوب يحتاج إلى وعي سياسي عالي الأخلاق، وأحزاب سياسية نزيهة من أغراض الصراع والتنافس (على النمط الغربي) ،لأن السلطة السيادية لن يتنازل عنها صاحبها (الشعب إلا إذا أُرغم) بتلك الصورة الواهمة التي تصورها القيم العلمانية والليبرالية الغربية ، بل لابد أولاً : من عقد إجتماعي قانوني يوثق العلاقة التنظيمية لتصبح وثيقة تأريخية ثابتة ودستورية جامدة، ولابد كذلك من وجود كيان تنظيمي داخل معادلة الدولة يمثل الشعب ومستقل عن الأحزاب ليحدث التوازن المفقود (بين كفة الشعب والحاكم) وتتأكد فعالية العقد الإجتماعي الذي تم توثيقه ليمنح الشعب حقه من السيادة والسلطة التنظيمية كمالك للمؤسسة وليس عاملاً لديها أوموظف لتمارس عليه حكم الإقصاء أو الوصايا والحجر الظالم .
خاتمة :
المؤتمر التأسيسي :
يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على القيام بدور التوازن الطبيعي بين مكونات الدولة المختلفة (مؤسسات الحكومة والمجتمع) ، ومن ثم هي الجهة السيادية العليا الوحيدة التي تملك حق إنتخاب عضوية الجمعية التأسيسية الذي يمثل البرلمان السيادي للدولة الإرترية ،وعضويته نواب ممثلين لكل الأقاليم الإرترية بنسب متساوية ليعملوا على أداء وظيفة إجتماعية حساسة يتوقف على وجودها حدوث التوازن التنظيمي بين صلاحيات المؤسسات السيادية الجديدة (الأمن والدفاع والقضاء والإعلام والإقتصاد السيادي) المستقلة عن صلاحيات المؤسسات السياسية (الوزارات المختلفة )(مالية، داخلية، خارجية ، سياحةوتجارة، تربية وتعليم …. إلخ)) .
– هذا المؤتمر من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للتعامل مع مفهوم السيادة الذي ظل ـ نتيجة الإستقطاب الحاد الذي تعرضت له قوانا السياسية من قبل الفكر الإستعماري الغربي ـ خارج إطاره الموضوعي.
– السيادة حقيقة ًلا تعني قوة الإخضاع والسيطرة القسرية للموارد البشرية والمادية كما يحلو للمفكر الغربي إعتقاده ، ولعل صيغة الإخضاع والسيطرة التامة هذه راقت للسياسيين من رموز الدول الأخرى (خاصة الإفريقية) لأنها أقرب لتحقيق مصالحها السياسية ، وكانت النتيجة بالنسبة لنا كإرتريين وقوعنا ضحية هذا المفهوم الخاطئ بعد الحرب العالمية الثانية الذي جعل الدوائر العالمية المتآمرة مع المستعمر الإثيوبي الصليبي تخضع المجتمع الإرتري لقرارها الفدرالي الظالم ومن ثم إستمرت مأساتنا بعد إنطلاقة الثورة نتيجة تأثر قياداتها بهذا المفهوم المنحرف عن الغاية التي إشتعلت الثورية من أجلها عام 1961(أي الحرية)، ليجد الشعب الإرتري نفسه خاضع لأداة قياديه تسعى للسيطرة على السلطة وعلى الساحة عملاً منها بمفهوم الإخضاع الكامل للقوى الثورية الأخرى لسلطته الحزبية (حزب العمل) كممثل شرعي للآخريات حتى تفرقت الكلمة في الساحة وإنشق الصف التنظيمي للثورة وضاعت المكاسب الثورية التي ضحى الشهداء بارواحهم لتحصيلها ، كل ذلك كان لتأثُّر القوى السياسية بمفهوم السيادة الخاطئ المبني على سياسة الإخضاع والسيطرة .
– لاشك في أن القيمة الإنسانية للسيادة لا يمكن تحقيقها مالم نحرر الإرادة الإجتماعية من قيد الإخضاع والسيطرة القسرية الراهن ، وبالتالي لابد لنا ونحن نسير في إتجاه هذا التحرير الواعي للإرادة الإرترية من عقد المؤتمرالتأسيسي المفتوح الموازي للمؤتمر الوطني المغلق(على قيادات الأحزاب السياسية) ، ولابد كذلك من تأسيس البناء التنظيمي من لبنات هذا الوعي الوطني بالسيادة الحقيقية التي إنتفضنا من قبل خمسة عقود لتحصيلها ، أي لابد من إدراك حقيقة أن السيادة من الناحية النظرية هي للشعب وحده ولكن من الناحية التطبيقية تقسم الى جزئين (سيادة المجتمع وسيادة الحكومة) وليست محصورة في سيادة الدولة(أو سيادة الحكومة وكفى) كما أقر بذلك الفقه السياسي الغربي ، ومن ثم علينا أن ندرك بأن حماية السيادتين يجب أن تتولاها جهة مستقلة (غير سياسية) لاينتمي أفرادها لأي حزب سياسي ، وذلك لأن نواب الحكومة والجمعية التشريعة في البرلمان هم في الحقيقة ممثلي قوى سياسية في المقام الأول وبالتالي المصلحة الحزبية تحكم علاقاتهم التنظيمية بالدولة والمجتمع ، وبالتالي هم ليسوا مؤهلين لحماية السيادة الوطنية كبناء مستقل عن العمل السياسي أو مخصص للشعب حقيقة لا وهماً، ومن يظن أن السيادة لا تنفك عن العمل السياسي فهو مخطئ لأنه واقع تحت تأثير قيمه الحزبية، بالتالي فإن وعاء الحكومة نفسه يعتبر مؤسسة سيادية من جانبها الإجتماعي وتعتبرمؤسسة سياسية من جانبها التنظيمي ، وبالتالي فإن حماية الحكومة كمؤسسة إجتماعية من سيطرة القيم السياسية المبنية على المصلحة الحزبية يقع على عاتق سلطة المجتمع (الجمعية التأسيسية) وشبكة الرقابة الدستورية القوية التابعة لها (مكاتب الرقابة الدستورية) ، ولا يقع على عاتق نواب الحكومة والبرلمان الممثلين لأحزابهم .
المؤتمر الوطني :
– هذا المؤتمر من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للتعامل مع مفهوم السياسة الوطنية الذي ظل نتيجة الإستقطاب الحاد الذي تعرضت له قوانا السياسية من قبل الفكر الإستعماري الغربي … خارج إطاره الموضوعي .
– بمعنى ضرورة رفض المفهوم الغربي المتطلع لفرض هيمنته من خلال فرض ثقافته السياسية المتمثلة في البعد العلماني للقراءة السياسية وأحادية السيطرة على الموارد البشرية والمادية عبر آليات التنظيم القمعي لإرادة المشاركة الواسعة في عمليات إتخاذ القرار وتشريعه وتنفيذه ، وتجاوزها لمهام وصلاحيات السيادة الشعبية للمجتمع الإرتري والإستحواز على أدوارها في الرقابة اللصيقة والمصادقة الشعبية على عمليات إتخاذ القرار وإجراءات تشريعه وتنفيذه .
– ذلك لأن مفهوم السياسة فقد إرتباطه بالقيم الإنسانية من خلال إعتماده للآليات المادية المجردة لفرز المكاسب والقيم المادية وتجاهل المكاسب والقيم المعنوية المرتبطة بحماية جوهر الإنسان ورعاية نموه الطبيعي وتقوية إمكانياته الفكرية والحسية والروحية من خلال ربطها بضوابط السير الأخلاقي وإتباع النموزج الفاضل لبناء شخصية الإنسان ، بل إقتصر جهد الفكر السياسي على تفريغ الإرادة الإنسانية من أي تكليف نحو رعاية الأخلاق والدفاع عن قوامتها في المجتمع ، وعليه صارت القوانين تدعو للتحرر من الإنضباط الأخلاقي للسلوك على مستوى الفرد العادي، كما أصبح السياسي همومه منحصرة في إستخدام وسائل التحايل والخداع لبلوغ هدف السلطة ، وبالتالي الصراع يستدعي ضرورة التخلص من الخصوم والإنفراد بالمكاسب أو حصرها في الفئة التي تنتمي لها.
– يتكوين الشق السياسي للسلطة التشريعية في البرلمان من نواب الجمعية التشريعية وهم ممثلي الأحزاب السياسية الذين يجرى إنتخابهم من خلال إجراءات تنظيمية داخلية لدى أحزابهم ليتم تصعيدهم منها للقيام بمهام التمثيل الحزبي داخل المؤتمر الوطن .
– لا تحتاج عملية تصعيد نواب الجمعية التشريعية الى إنتخابات عامة طالما أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب السياسية التي ستقوم عبر ممثليها بأداء مهام فنية (كالإدارة والإشراف والمتابعة والتنفيذ للخطط والبرامج والمشروعات الوطنية) لتنمية القدرات البشرية والمادية وذلك لتوفر الإمكانات والمؤهلات العلمية … وهي مهام سياسية توازي مهام من هم نواب الشعب وممثليه لدى المؤسسة التشريعية والمؤسسات الحكومية المختلفة.
– بعدتحديد قائمة المنتخبين لعضوية (الجمعية التشريعية) يقوم كل حزب على حدى برفع القائمة الى اللجنة التحضيرية المؤقتة للمؤتمر الوطني أو (لجنة تحضير مؤتمر السياسية الوطنية) المنتخبين من عضوية المجالس المحلية التسعة وبنسب متساوية .
– يٌعْقَد المؤتمر وبعد كلمات الإفتتاح لممثلي عضوية المؤتمر من الأحزاب المشاركة والضيوف يتم الإعلان في الجلسة الإفتتاحية عن عضوية الجمعية التشريعية المشكل من عضوية جميع الأحزاب المسجلة قانونياً لدى مسجل الأحزاب ثم ترفع الجلسة .
– في جولات المؤتمرالأخرى يتم إجراء القرعة السرية المباشرة والحرة وتشرف سكرتارية المؤتمر على عملية سحب القرعة وبعد إعلان النتيجة يمنح الحزب الفائز بأعلى نسبة حق تشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس مجلس الوزراء من عضوية حزبه وفق النسبة المخصصة له حسب الدستور.
– توزع الحقائب الباقية الأحزاب الأخرى التي تم إختيارها عبر القرعة من داخل المؤتمر كالتالي :
– يحظر تعيين أعضاء الجمعية التشريعية في أيةَ مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ، كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية المجالس المحلية وأيةَ مناصب في السلطة المحلية .
– تمنح النساء نسبة 15% من مقاعد الجمعية التشريعية ووظائف الرقابة الدستورية (أي التابعة للجمعية التأسيسية) ، ذلك أن 85% من مهامها تتركز في كونها حاضنة ومربية للأسرة الأرترية وقدوة ومعلمة لنشئ الأجيال القادمة وشريكة الزوج في حياته ومشاريعه الخاصة .
إختصاصات الجمعية التشريعية:
1. إعفاء مجلس الوزراء من منصبه بعد المصادقة النهائية على القرار من الجمعية التأسيسية.
2. تقديم مقترح إعلان الحرب أو حالة الطوارئ لأمانة الجمعية التأسيسية لإجازته النهائية .
3. الموافقة على قرارات العفو العام بعد الأخذ بوجهة نظر أمانة الجمعية التأسيسية.
4. إقرار السياسة العامة للدولة بشكل نهائي بعد المصادقة عليها من الجمعية التأسيسية .
5. الموافقة على إجراء التوقيع على إتفاق تعديل حدود الدولة أو الإتحاد أو التحالف أو الدفاع المشترك أو الصلح أو السلم مع الدول المجاورة بعد إجازتها من الجمعية التأسيسية .
6. توجيه الإتهام لرئيس مجلس الوزراء في حالة إرتكابه أعمال غير قانونية مثل الحنث باليمين أو محاولة تعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة . وإحالته للجنة تفسير القانون بالجمعية التأسيسية .
7. إقرار ومناقشة القوانين عدا تلك التي تختص بها الجمعية التأسيسية لإرتباطها بمهام سيادية بحته .
8. منح الثقة للحكومة وسحبها .
9. الإجازة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بعد مناقشتها والتصويت عليها فصلاً فصل ، ولمجلس الوزراء حق إجراء التعديلات المناسبة على الموازنة بمايكفل التوزيع العادل للمشاريع والتحديد العلمي للأولويات حفاظاً على سلامة المواد الوطنية .
10. مناقشة الحسابات الختامية للدولة سنوياً ، بحيث يتم التصويت عليها فصلاً فصلاً .
11. المناقشة والإقرار الأولي لمشروعات الخطط العامة للتنمية .
12. المناقشة وتحديد موقفها بعد القراءة الأولى للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين ، أو بقانون مجلس الوزراء وقانون تقسيم الأقاليم والمتعلقة بشئون الحكم المحلي وعلى الأخص قانون السلطة القضائية وتحيله للجمعية التأسيسية للموافقة عليه .
13. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، التي تملك حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة .
14. والباب مفتوح لإضافة وحزف البنود التي يجمع عليها الأغلبية عندما تنعقد الجمعية الوطنية للبرمان بشقيها السياسي والسيادي .
مانقوم به هنا من خلال طرح مثل هذه الأفكار الثورية ليس سوى محاولة لتفعيل وعي ثقافي جديد للثورة الشبابية القادمة بعزم لإقتلاع السلطة القهرية سواء كانت سلطة إسياس أو غيرها وسوى جاء التغيير بالسلاح أم بعوامل طبيعية .. فالغرض من التحول الديمقراطي هو الإنتقال من وضعية الوصايا الى وضعية مستقلة وإرادة حرة كريمة تمارس حياتها بطمأنينة وشعور بالإستقرار الحقيقي بعد رفع مقامنا داخل إطار الشعب الى مقام السيادة الشعبية المستحقة ، حيث لا إستقرار أو حياة كريمة بعيداً عن عودة مجرى الحقوق السيادية لمصبها ومستحقها (الشعب ونوابه) ، وبذلك نسهم بوعي في تجاوز الأزمة الحالية وتجفيف نزيفها الذي إستمر طوال مرحلة الكفاح المسلح وحتى لحظة كتابة هذه المقال .
————-
لماذا ندعو الى سلطة سيادية منفصلة عن السلطة السياسية (2)
نّشر في: 21 أبريل, 2012
سعدت كثيراً لوجود أشخاص يملكون الجرءة على النقد البناء والتفاعل الجاد مع القراءة بعكس من يكتفي بالنقد الصامت لرفضه مبدأ مشاركة الآخرين أفكاره ، فكل الشكر والتقدير للدكتور عبدالله ، وأرجو أن يستميحني العذر إن كان ردي قاسياً وأن لا يتسبب ذلك في إحجامه من التفاعل البناء الذي أكرمنا به …. وسأجزئ الرد حسب التقسيمات التي أوردها ….
o الإجتهاد : أظهر أفكاري وكأنها إجتهاد في الأصول وليس في الفرعيات المباح لنا تناولها والأخذ والعطاء فيها ، والرفض والقبول لتفاصيلها ، ولهذا ذكرنا بأن السلطة السيادية هي كما ذكرها الغرب تماماً (سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية )(ونسي الإعلامية “كسلطة رابعة” و العسكرية “كسلطة خامسة”) لأن السلطتين الأخيرتين يجب أن لا تلحق بالجهاز التنفيذي بل يجب إعتبارها سلطة قائمة بذاتها كالقضاء ، ولعل هذا الإلحاق هو الذي منح الغرب حق السيادة (شريعة القوي) ليمارس سلطته الإستعمارية على باقي المجتمعات وهو ماسيمنح النواب القدرة على الإحتكارغيرالشرعي لوسائل العنف ، كما أن إستقلالية السلطة العسكرية تتم حسب موجهات الدستور وقيد المصادقة الدقيقة على أي إجراء السلطة العسكرية من قبل مكتب الرقابة الدستورية التابع للمستوى الإداري للجهاز ، ممايجعل الموظف والمجند متحرراً من أي صلة تنظيمية بغير القانون الأساسي واللائحة التنظيمية المنفذة للقانون ، بحيث لن تكون هناك صلاحيات شخصية للواجهات القيادية في الجهاز العسكري تتجاوز بنود اللائحة التنظيمية والقانونية وسيادة المجتمع.
o وبهذا وحده نجعل إحتكار الدولة الشرعي لوسائل العنف لا يمنحها الحق لممارسة غير شرعية لتلك الوسائل ، ولم أرى في أي بحث علمي محاولة لمعالجة تنظيمية لحماية المجتمع الأعزل من تجاوزات الإدارة الحاكمة ……وإذا كانت لديك مقترح في هذا الشأن نرجو أن لا تبخل به .
o الملاحظة:
كانت ملاحظته في غير مكانها فلا وجود للخلط في مقالي بين السيادة كمفهوم والتجارب الإنسانية في هذا المجال …. ولهذا كان التكلف من نصيبه ولم اشهد أي لغة تبريرية أو دفاعية إلا في كلماته …
لم يكن كافياً أن تضع بعض القصاصات على التعليق لتعبر عن الإبهام الذي أصابك والتشويش الذي عانيت منه نتيجة التناقض بين ضميرك الذي إرتاح من المقال وعقلك الظاهر الذي رفض ذلك لأنه تشرب نظريات مادية وتشبع بمصالح آنية وأسس كيان فكري مرتبط بمبدأ الدمج بين السلطتين ، فمان ما كتبته دفاعاً عن كبرياء هذا الوجود الذي تنتمي إليه ولوحت بعصا نقدك على إستحياء ، وجاءت نقاطك كالتالي :
أولاً : الدستور كعقد إجتماعي هو الضامن للسيادة بكل ماتعنيه ، وأعظم هذه المعاني الحرية (جوهر الدستور).
– الدستور ضامن لسيادة من ..؟! الشعب …؟! لم نشهد حتى الآن شعب ينعم بسيادة حقيقية … كالتي ينعم بها النواب ….!! حتى عربة الوزير عندما تمر تقف الحركة المرورية على طول الطريق المؤدي الى موقع زيارته … تتعطل مصالح الشعب حينها من أجل أن لا يقف الوزير لحظة في زحمة السيارات كباقي أفراد الشعب وهو موقف من الوزير غير إنساني ( ربما كنا نتجاوز عن هذه الزلة إن كان الوزير أصيب بزبحة قلبية وكان في حالة مرضية تستدعي أن يتجاوب المارين مع حالته الإنسانية)أما وهو صحيح معافى فذلك تعد واضح على كرامة الشعب… وتتحدث عن الحرية التي يرعاها الدستور…هذا أبسط مثال وقس على ذلك في باقي شئون المجتمع ليتضح لك عجز الدستور عن تحقيق قيم الحرية والسيادة لغير النواب ….!!!!
– هذا بالإضافة الى أنني عندما أدعو الى فصل بين السلطة السيادية والسياسية لا أرمي الى عزل السيادة (المقيدة) عن الرئيس أو الوزير بقيود الرقابة التنظيمية والمصادقة الإدارية من قبل مكاتب الرقابة الدستورية ، كي لا ننسى أن الرئيس والوزير ليسا سوى موظفين لدى صاحب المؤسسة (الشعب). هذه هي الترجمة العملية لمبدأ سيادة الشعب … وبهذا فقط نحمي سيادة المجتمع ونراعي قيم الحرية والكرامة على مستوى التنظيم والإدارة .
—————–
ثانياً : الجمعية التاسيسية هي جمعية ينتخبها الشعب (أو ممثلية/النواب) لوضع الدستور ، وهي حسب مدلولها اللغوي تؤسس المبادئ الدستورية وتضع القانون الدستوري الذي يكون الإطار الذي يحكم كل التشريعات القانونية التي يضعها المشرع (السلطة التشريعية) .
– قبل الرد على قولك هذا أرجو قراءة الفرق بين الجمعية التاسيسية الأمريكية والفرنسية :
الجمعيات التأسيسية على النمط الأمريكي
هي الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط, دون أن تملك الحق في مباشرة أي صلاحيات أخرى, وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية, وبمعنى آخر, فهي ﴿جمعيات تأسيسية متخصَّصة ﴾, يتم إنشاؤها لغرض محدّد بالذات ألا وهو وضع الدستور, وينتهي دورها وتزول من الوجود بمجرد انتهاء عملها وإنجاز المهمة الموكلة إليها, ومثالها مؤتمر فيلادلفيا الذي تولى وضع الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1787. وقد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في عام 1789, وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام 1791, ثم أخذت به أيضاً في وضع دستورَيْ سنة 1848 وسنة 1875, غير أن الجمعيات المنتخبة التي كانت تمارس نيابةً عن الشعب الفرنسي صلاحية السلطة التأسيسية ( أي مهمة وضع أو تعديل الدستور) كانت تعرف اصطلاحاً باسم “الجمعية التأسيسية بدلاً من اسم “المؤتمر الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية.
الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي
الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي ، وهي تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور, بل يكون لها وظيفة مضاعفة, حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد, وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة .
وظهر مثل هذا النوع من الجمعيات ـ بصورة أساسية ـ في أعقاب قيام الحركات الثورية,حيث يسند للجمعية التأسيسية ـ بسبب التغيير الجذري الشامل الذي تحدثه الثورة في بنية المجتمع ـ ليس فقط وضع الدستور للبلاد, وإنما أيضاً مباشرة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ريثما يتم تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بعد وضع الدستور الجديد, ولذا توصف مثل هذه الجمعيات بأنها ﴿جمعيات تأسيسية عامة ﴾, وهو الأسلوب التقليدي المتبع في فرنسا.
– إذن من خلال الفرق بين الجمعية الأمريكية والفرنسية ندرك مساحة الحرية المتوافرة في إختيار الطريقة التي توافق الظروف الداخلية والوعي التنظيمي لكل دولة على حدى ، وبالتأكيد المسألة ليست قطعية بل قابلة للنقاش وللأخذ والرد ولحوار وطني تنتج عنه مسألة الإجماع على الرأي الأصوب واستفتاء الشعب عليه كشرط اساسي .
– تحت عنوان : تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية ذكرت موسوعة المعرفة (1)
أن هذا الأسلوب على الرغم من أنه يعدّ تطبيقاً سليماً للديمقراطية النيابية, إلا أنه يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى تحجيم دور الشعب وحصره في إطارٍ ضيق يقتصر على المساهمة السلبية التي لا تتجاوز اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون أن يتدخل الشعب في تحديد اتجاهات الجمعية أو التأثير بالإيجاب في مضمون الدستور الذي يتحدد مصيره بالكامل من قبل أعضاء الجمعية النيابية المنتخبة .
ولهذا إعتمدنا شرط عدم إنتماء عضوية الجمعية التأسيسية للأحزاب السياسية .
– كما أن الفقه الدستوري حدد شروط معينة لإعداد الدستور الذي تضعه الجمعية التأسيسية ديمقراطياً, وهذه الشروط تتمثل في الآتي (2):
– 1 . يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب, لا أن يُعيَّن أعضاؤها من قبل الحكومة أو قادة الانقلاب .
– 2 . يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطياً, وبمعنى آخر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وفقاً لمبادئ الاقتراع العام, الحُرّ, المتساوي, السري, المباشر ( أي على درجة واحدة ), كما يجب أن يتم فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها في صناديق الاقتراع تحت إشراف ورقابة القضاء. ولهذا قيل بأن سلامة هذا الأسلوب ( أسلوب الجمعية التأسيسية ) تتوقف على صحة العملية الانتخابية ودقة التمثيل النيابي .
– 3. ولكي يكون الانتخاب حراً بالمعنى الصحيح, فإنه من الضروري أن يكون هنالك خيارات متعددة أمام الناخبين . وهذا ما توفّره الأحزاب السياسية les partis politiques في الدول الديمقراطية. وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية القائمة ـ دون استثناء ـ للمشاركة في عملية انتخاب الجمعية التأسيسية .
– 4 . يجب أن تكون الحريات العامةles libertés publiques في الدولة مصانة ومكفولة, وإلاَّ فإنَّ اشتراك الأحزاب السياسية المختلفة في الانتخابات سيكون بلا معنى, لأن هذه الانتخابات ستجرى في جوٍ من القمع والكَبْت للحريات .
– 5. وبالإضافة إلى ما سبق, ينبغي على الجمعية التأسيسية ـ التي تتوافر فيها الشروط التي ذكرناها آنفاً ـ أن تمارس عملها بحريّةٍ وحيادٍ تامّين, أي أن تكون بمنأى عن كل الضغوطات السياسية les pressions politiques التي قد تؤثر في عملها
– كما أن هناك أنواع للدساتير :
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة و غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
تختلف الدساتير وتتعدد أنواعها باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى تلك المجموعة التي تبين نظام الحكم ومظاهره في الدولة.
على أن أهم التقسيمات التي ينتهجها الفقه الدستوري في شرح أنواع الدساتير تنطلق من زاويتين، تتعلق الأولى بالكتابة وتُميز بين دساتير مكتوبة وعرفية، والثانية تتعلق بالثبات أو التعديل وتميز بين دساتير جامدة ومرنة.
الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية:
كانت الأنظمة الدستورية قديماً بكليتها عرفية، ثم أخذت الشعوب تنتزع السلطة من حكامها انتزاعاً، وتضطرهم إلى إصدار الوثائق القانونية المكتوبة التي تضمن حرية الشعب وتكفل مشاركته في السلطة، وكانت هذه الوثائق مقصورة على ما يواجه النزاع بين الحاكم والمحكومين.
– والدساتير العرفية
هي الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطات العامة وحريات الأفراد مما لم ينص عليه في قانون مكتوب، وإنما في التقاليد والأعراف والسوابق.
– الدساتير المكتوبة: هي الدساتير المدونة والموضوعة من قبل سلطة تأسيسية مخصوصة لذلك، سواء صدرت بوثيقة واحدة، أو عدة وثائق.
– الدساتير المدونة وغير المدونة
ماجنا كارتا.
يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
– الدساتير غير المدونة
وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و تسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء ، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
– الدساتير المرنة
هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
– الدساتير الجامدة
هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية .
ولابد من الإشارة إلى أن صلابة الدستور الجامد لا تعني خلوده، فالغرض الأساسي من هذه الصلابة، كفالة الاستمرار والاستقرار للأحكام الدستورية، والنأيُ بها عن الأهواء السياسية والحزبية في المجالس التشريعية، بالنظر لخطورتها وعُلوها على سواها من قواعد قانونية، فالدستور من الناحية الحقوقية، قانون، والقانون بطبيعته صك دائم التطور، ومن الناحية السياسية يحدد تنظيم الدولة في ظروف سياسية واجتماعية معينة ومتى تعدلت هذه الظروف وجب تعديل أحكامه.
ومع تقرير مبدأ تعديل الدساتير الصلبة بإجماع الفقه، بدر الخلاف حول السلطة المخولة هذا التعديل، فقد أنكر بعضهم وأشهرهم ڤاتيل Vattelعلى أعضاء الهيئة التشريعية أن يعدلوا الدساتير، لأن المشترعون الأعضاء، يستمدون سلطتهم من الدستور ولا يستطيعون تعديله إلا بتهديم أساس سلطتهم، وقال آخرون: إن التعديل صلاحية معقودة للسلطة التي يعينها الدستور، ومن ثم فإن الأمة تستطيع تعديل الدستور متى أرادت لأنها غير مقيدة بشيء وتستطيع أن تتجاوز الأشكال التي يعينها الدستور، وبما أن الجمعية التاسيسية حسب تقديرنا تقوم مقام الأمة وتمثلها من الناحية السيادية، فلها حق تعديل الدستور.
وقد ميز الفقه الدستوري في الدساتير الصلبة بين نصوص يُحظر تعديلها إطلاقاً، ونصوص تقبله بشروط خاصة تحددها الجمعية التاسيسية لكونها سلطة فنية وهذا هو إختصاصها.
– وقد جاء في دستور فرنسة الأول لعام 1791م: «أن الأمة لها الحق الذي لا يَبْلى في تغيير دستورها، لكن وفق الشكل الذي نص عليه الدستور».
–
ثالثاً :الديمقراطية الغربية هي نتاج للتجربة الإنسانية وليست نبتاً مبتوراً عن التطور البشري في مجال الحكم ، وعليه حتى يأتي البشر بوسيلة للحكم أجود منها تظل هي الخيار الأمثل المطروح لتداول السلطة .
• ما هذا هل تريد التظاهر بأنك لا علم لك بالإزمة السياسية الواقعة بين علماء الغرب ومفكريه وبابوات الكنيسة ، ألم تسمع بمحاكم التفتيش وتدرك أسباب العقدة التي جعلت الفلاسفة يعقدون العزم لمحاربة القيم الأخلاقية وتجريدها من المجتمع كي لا يتركوا لأعدائهم (البابوات)أرضية لممارسة السلطة على المجتمع ، ألم تدرك بأن السبب الرئيسي لغياب السلطة من الشعب هو تأثره بقدسية القيم الدينية وتعلقه بمبادئ الأخلاق ممايجعله فريسة سهله في زعمهم لأعداء الفكر الغربي المتنورالناهض للتغيير والتحول نحو التحرر من قيد السلطة الدينية ….ومن سلطان الآلهة السمواوية ليصبحوا هم المشرعون لسلطة آلهة أرضية تضمن لهم عدم إرتداد الوضع مجدداً لصالح الدين .
• هذه هي ثمار الديمقراطية الغربية الصانعة لأجيال من المفكرين (السكند هاند) أي المقلدين لمن سبقوهم من علماء دون قراءة علمية مجردة منهم للنتائج الكارثية التي أحدثتها أو ستحدثها النظريات الغربية في السياسة والفكر والإجتماع .
• هل هذا هو النتاج الطبيعي للتجربة الإنسانية أم أنها عملية قيسرية لتشويه المجتمعات وتحويلها الى واجهات مصورة لحياة فارغة من الروح والقيم الأخلاقية ، ولا أدري لماذا تتكلف عناء جهدك للتبرير عن جرائم الغرب ضد الإنسانية ألا ترى معي أن ذلك منك يعتبر موقف عاجز .
• فيا أخي التجارب الإنسانية تصبح إنسانية عندما ترعى القيم والأخلاق ، أما عندما تصبح وسيلة لطمس هذه القيم والأخلاق فعندها يصدق عليها تعبير تجارب إستعمارية ، شعارها الفصل بين الدين والدولة وبين الأخلاق والسياسة وبين السلطة والشعب وبين السيادة وصاحب المؤسسة(المجتمع) .
• ومن حقنا عندها أن لا نعتد بمثل هذه تجارب تخلو من الطابع العلمي النزيه ،هي فرضيات إعتنقها الغرب ورفع مقامها الى مستوى النظرية الثابتة والقاعدة التنظيمية للدولة نتيجة وقوعه في الإستلاب الثقافي من قبل مفكريه(الملحدين) .
• والأهم بالنسبة لنا هو أن هذا الإرث إنتقل إلينا عبر قرارات المستعمر الأجنبي وإشراف قبة الأمم المتحدة ، ولهذا لا يشرفنا أن ندعي بأنه يمثل إرث حضاري للمجتمع الإرتري .
رابعا: نظام المؤتمرات المفتوحة والذى لا تحكمه اطر تنظيمية متماسكة كالأحزاب انما هو تكرار لتجربة المؤتمرات الجماهيرية الليبية التى خدع بها القذافى قومه فأطاعوه فهلكوا بتسلطه عليهم كديكتاتورية فردية تحرم عليهم التنظيم حتى لا يواجهوا تسلطه.
كما أن هكذا مؤتمرات مخرجاتها غالبا ما تحرف ولا تمثل الا الادارة التى تمسك بتلابيب التنظيم لها, اضافة لاشكالية شرعية المشاركة غيرالمنضبطة فى مثل هذه التظاهرات الشعبوية.
أحقاً أنك لم تميز الفرق بين المؤتمرات الشعبية (النموزدج الليبي) والمؤتمرات المؤتمرات المفتوحة (النموزج الإرتري المقترح) ، أم أنك تحاول إخفاء الحقيقة ، حسناً ساعتبرك تجهل الحقيقة وسابين الفرق ، هذا النموزج يهدف الى نقل الشعب الإرتري من طور الوصايا (كالذي عانته ليبيا في ظل القزافي أو إرتريا في عهد إسياس) الى طور التحرر الحقيقي ، وليست تكرار لتجارب سابقة إنما تجد من كل بستان زهرة لتشكيل نموزج إنساني بمعنى الكلمة تعبر عنه البناء التنظيمي للدولة “حكومة ومجتمع” .
لا أدري ماهي معايير التماسك لديك ولكن وحدة الإنتماء والولاء لدى أعضاء المؤتمرات المفتوحة للشعب تجعله إطاراً متماسكاً ، حيث لا يوجد هنا أهواء تفرق الأعضاء طالما أن إنتماءهم للدائرة الجغرافية ليس محل شك .ولا أعتقد أن الأحزاب تتمتع بمثل هذه المميزات المذكورة حتى نقوم بتفضيلها .
كما أن الهدف الحقيقي من بروز هذا الشكل من البناء التنظيمي ليس الدعاية لجهة تنظيمة أخرى غير الشعب ولا وجود لصراع داخلي بين أبناء المنطقة الواحدة طالما أن مصالحهم واحدة ومصائرهم واحدة ، ولهذا فإن إنصهار المكون الإجتماعي داخل هذا الإطار دون تمييز بينهم من ناحية الدين والعرق واللون واللغة سيجعل من البناء الإجتماعي نموزج حي لقوة التماسك .
كما أن أوعية المؤتمرات ستصنع لتدريب الجماهير على إدارة شئونها والوعي بمصالحها التنظيمية ، والإدارة التي يتم إنتخابها من داخل الدائرة الصغيرة موافقة لشرط عدم الإنتماء لأي حزب سياسي ، لأن التفرق لمصالح الشعب يقتضي عدم الإنتماء لكيان تنظيمي آخر له مصالح متضاربة مع مصالح الشعب.
وأخيراً تمنيت منك أن لا تشير بهذه الصورة غير الكريمة لتعبر عن إستهتارك بالتظاهرات الشعبية لتصفها بغير المنضبطة ، فهلا ضبطت تعابيرك أولاً وإبتعدت عن أسلوب الإستفزاز والتنطع بالنقاء الفكري والإستعلاء غير المبرر على من ربانا وتعب في تنشئتنا ونحن أطفال حتى بلغنا هذه المنزلة ، فهل إنكار الجميل هو ماستقدمه لأباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا مستقبلاً لمجرد أنهم أميون .
خامسا: السلطة السيادية يمكن أن تكون مؤسسة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية مصاحبة لوجودهما مع تحديد الأدوار الممنوحة لكل منها.مثال مجلس السيادة المكون من عدد من الأعضاء الممثلين لكافة فئات الشعب(الجهوية/ الاقليمية/ الاثنية/ الثقافية/ الاجتماعية/ الاقتصادية/ المطلبية….الخ ). وكيفية اختيار هذه السلطة تحددها بنود الدستور.
– هذا بالفعل ماقصدته أن تكون السلطة السيادية موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية مصاحبة لوجودهما …أما عن تحديد الأدوار فالمجال ليس مغلق أمامنا يمكننا إقتراح تلك الأدوار الممنوحة لكل منهم والخطاب الفصل يكون للجماعة أي باستفتاء مجموع الشعب الإرتري لتضييق المنافذ التي يحاول المتسلقين إستغلالها بعيداً منه .
لمحة تعريفية بالجمعية التاسيسيةالمقترحة:
تتألف الجمعية التأسيسية من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين:
1. نائبا الرئيـس: يتولى النائب الأول صلاحيات ومهام رئيس مجلس الأعيان في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والمهام في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول .
2. مساعدا الرئيس ، ويقومان بما يلي:
a) مساعدة رئيس الجمعية التأسيسية في إدارة الجلسات
b) جمع الأصوات وفرزها ، والتأكد من نتيجة التصويت بإشراف الرئيس
c) تحرير محاضر جلسات الجمعية التأسيسية السرية ، وتوقيعها ، وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق .
لجان الجمعية التأسيسية :
يبلغ عدد لجان الجمعية التأسيسية تسع لجان على عدد الأقاليم الإرترية، وهي:
1. لجنـــة الشــؤون القانونيــة والسيادية .
2. لجنــة الشؤون الماليــــة والاقتصاديـة .
3. لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة .
4. لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافيــة .
5. لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية .
6. لجنـــــة الشــــؤون الإداريــــة .
7. لجنــــة شـــؤون الزراعـــة والمياه .
8. لجنة شؤون السياحة والتراث .
9. لجنة شؤون السكان والتنمية .
تنتخب الجمعية أعضاء كل لجنة من اللجان السابقة لمدة سنتين .
• تجتمـع كل لجنة بدعوة من الرئيس لتنتخب من بين أعضائها مقرراً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها ، وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ، ودعوة أعضائها للاجتماع . ويجوز لرئيس الجمعية أن يرأس اجتماع أي لجنة يرى لزوماً الاشتراك في مداولاتها .
• وللجمعية التاسيسية أن تشكل لجاناً مؤقتة ، تحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها .
جمعية تفسير الدستور:
تتشكل الجمعية من رئيس الجمعية التأسيسية (رئيساً لها) ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم تنتخبهم الجمعية التأسيسية من أعضائها المتخصصين في القانون، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية.
وتمارس الجمعية التأسيسية المهام التالية :
1. تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء ، أو بقرار تتخذه الجمعية التأسيسية ، أو الجمعية التشريعية بالأكثرية المطلقة .
2. محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم .
وظائف الجمعية التأسيسية
تضطلع الجمعية التأسيسية بحسب النصوص الواردة في الدستور والنظام الداخلي للجمعية التأسيسية بثلاثة وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية ووظيفة المؤسس.
أولا: الوظيفة التشريعية
تتمثل الوظيفة التشريعية للجمعية التاسيسية بالأمور التالية:
1. اقتراح مشاريع القوانين : حيث يجب أن تنص مادة ما (….) من الدستور على انـه ” يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء البرلمان أي من الجمعية التأسيسية أو التشريعية أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في الجمعية التأسيسية لإبداء الرأي فإذا رأت قبول الاقتراح أحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للجمعية التشريعية في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2. مناقشة مشاريع القوانين حيث يحيل الرئيس مشاريع القوانين المقدمة من قبل الجمعية التشريعية إلى اللجان المختصة التي تقوم بدراستها واتخاذ قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته ومن ثم ترفع للرئيس الذي يحيله بدوره على أعضاء الجمعية التأسيسية للتداول والمناقشة.
3. إقرار مشاريع القوانين : تنحصر صلاحيات الجمعية التأسيسية في مرحلة الإقرار في ثلاث مواقف ( قبول المشروع، رفض المشروع، تعديل المشروع) وذلك على النحو التالي :
إذا وافقت الجمعية التأسيسية على مشروع قانون كما اقرته الجمعية التشريعية يرسل للحكومة ليرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه وإصداره حسب الأوضاع التالية :
1) إذا لم توافق الجمعية التأسيسية على مشروع قانون كما اقرته الجمعية التشريعية سواء كان قرار الجمعية التأسيسية بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى الجمعية التشريعية لإعادة النظر فيه.
2) إذا قبلت الجمعية التشريعية مشروع القانون كما ورد من إدارة الجمعية التأسيسية تحيله الى الرئيس ثم الجمعية التأسيسية مرة ثانية لتصديقه بمجموعه ثم يرسل إلى الحكومة لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق النهائي عليه.
3) إذا رفضت الجمعية التشريعية تعديل مشروع قانون بالصيغة التي اقرتها الجمعية التأسيسية أو بدل أو غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجري عليه المعاملات التي تجري على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى .
4) إذا لم توافق الجمعية التأسيسية للمرة الثانية على قرار الجمعية التشريعية كما أعيد إليه يبلغ رئيس الجمعية التأسيسية رئيس الجمعية التشريعية وجوب عقد جلسة مشتركة تجتمع فيهاالجمعيتان لبحث المواد المختلف فيها برئاسة رئيس الجمعية التاسيسية، ويشترط عندئذ لإقرار المشروع أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة المشتركة.
ثانياً : الوظيفة الرقابية
إن مهمة رقابة الجمعية التأسيسية على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الجمعية بموجب أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية ويمكن تقسيم الوظيفة الرقابية للجمعية التأسيسية من حيث الطبيعة إلى نوعين:
الرقابة السيادية :
وهي الرقابة على أعمال الحكومة في إدارة شؤون الدولة ومراقبة مشروعية عملها بحيث يكون مطابق للدستور .
والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بما يحقق ويصون المصلحة العامة.
وفي نفس الإطار تتسع رقابة الجمعية التأسيسية للحكومة في سياستها الخارجية في معاملاتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي والمواقف السياسية التي تتخذها الحكومة.
وتمارس الجمعية التأسيسية وظيفتها الرقابية من خلال عدة وسائل محددة في الدستور والنظام الداخلي للجمعية وتتلخص هذه الوسائل في الآتي:
أولاً : على مستوى البرلمان :
• توجيه الأسئلة :
حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن يوجه إلى الوزراء أسئلة حول أي أمر من الأمور العامة.
• توجيه الاستجوابات :
حيث يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن يوجه للوزراء استجوابات ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو احد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة والاستجواب أهم واخطر على مركز الوزارة من السؤال فلا يقصد به الاستفهام عن شيء يجهله مقدم الاستجواب بل مناقشة سياسة الوزارة في أمر من الأمور التي تخصها وانتقادها.
• طرح موضوع عام للمناقشة :
حيث يجوز لعضو الجمعية التأسيسية أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة، كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، وذلك بالحوار بين أعضاء الجمعية التأسيسية والحكومة تتناول فيه الحكومة الرأي مع أعضاء الجمعية وفي هذا فائدة فمن ناحية تلبي رغبات الجمعية بالاطلاع على سياسة الحكومة، ومن ناحية أخرى تحقق المناقشة إثراء للرأي والتشارك في اتخاذ القرارات تحقيقاً للمصلحة العامة.
• الاقتراحات برغبة :
حيث يجوز لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون أو اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها، أن يطلب من الرئيس أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
• العرائض والشكاوى :
حيث تقوم الجمعية التأسيسية بالاطلاع على هموم وقضايا المواطنين الخاصة والعامة، فيحق لكل إرتري أن يرفع
إلى الجمعية شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.
الرقابة المالية :
تمارس الجمعية التأسيسية دوراً رقابياً على الشؤون المالية للدولة من خلال ما يلي:
1) المشاركة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
2) الرقابة على فرض الضرائب حيث لا تفرض أية ضريبة أو رسم إلا بقانون صادر عن البرلمان بشقيه السيادي والسياسي .
3)الرقابة على عقود الامتياز: حيث يجب أن يصادق البرلمان بشقية بقانون ما على كل امتياز يعطى الحق لمنح
أي أمر يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة في البلاد.
وبصدور أول دستور أرتري في المستقبل ، نرى أن ينص هذا الدستور على أن السلطة التشريعية للقوانين العادية
تناط الى الجمعية التشريعية والسلطة التشريعية للقوانين الدستورية تناط الى الجمعية التاسيسية وأن البرلمان
يتألف من الجمعيتين .
رئاسة الجمعية التشريعية : مدة رئاسة الدورة في الجمعية سنة واحدة.
مدة العضوية في الجمعية: أربعة سنوات
رئاسة الجمعية التأسيسية: مدة رئاسة الدورة في الجمعية سنة واحدة .
مدة العضوية في الجمعية : إثنتى عشر سنة .
ثانياً: على مستوى الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة:
1) إنشاء مكاتب للرقابة الدستورية على الأجهزة التنفيذية المختلفة للوزراء .
2) إنشاء مكتب للرقابة الدستورية في الدوائر المختلفة للجان ومكاتب مجلس الوزراء
ومكتب الرئيس .
3) إنشاء مكاتب للرقابة الدستورية في الأجهزة العسكرية المختلفة .
4) إنشاء مكتب للرقابة الدستورية في الأجهزة الإعلامية العامة والخاصة .
5) إنشاء مكاتب للرقابة الدستورية في مؤسسات الخدمة العامة الرسمية على جميع المستويات الجغرافية .
الحاشية :
(1) موسوعة المعرفة
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1#.D8.A7.D8.AB.D9.8A.D9.88.D8.A8.D9.8A.D8.A7
(2)المصدر السابق .
————————————-
لماذا ندعو الى سلطة سيادية منفصلة عن السلطة السياسية – (1)
نّشر في: 18 أبريل, 2012
مدخل : قد بلغ علم الجميع مدى التأثير الكارثي الذي أحدثته النظم الديكتاتورية في دول العالم الثالث والمتقدم عموماً و إرتريا خصوصاً ، أي ماأحدثته نظم دمج السلطات السيادية بالسياسية بصورة متجاوزة للأصول (الشعب) ومعبرة عن قيم إستعمارية إنعزلت بسببها الشعوب الإنسانية عن إتيان شئونها العامة بل والخاصة لفراغ يدها من أية صلاحيات سيادية لحماية مكتسباتها التأريخية والثقافية والسيادية ، بحجة أن السلطة التنظيمية (السلطة السيادية والسياسية) يجب أن تتجمع في يد النائب ، وبهذا تحول النائب من وضعيته العادية كموظف الى وضعية أخرى أشبه بالأسطورية حيث أصبح يملك شرعية أكثر صلاحية من الشعب نفسه(صاحب الأمر والنهي)، وكأننا بذلك عدنا القهقري الى العصور المظلمة وعلى مقربة من عصر الكهوف والدينياصورات المنقرضة.
وإن يكن ذلك فإن تحديد معالم نظام عادل يتجاوز (المرحلة الديكتاتورية) مرحلة إسقاط وجود الشعب عن عرشه وتنصيب وجود آخر مكانه (النواب) هو المخرج الأساسي من الأزمة الإنسانية التي تعانيها الشعوب اليوم عامة والشعب الإرتري خاصة، فماعانيناه منذ صبيحة الإستقلال وحتى الآن لم يكن فقط لأن إسياس أفورقي جعل المسار التنظيمي الإرتري ينحرف 180 درجة عن غايته الثورية التحررية التي إنطلق الشعب الإرتري بكامل مكوناته الإجتماعية لتحقيقها طلباً للإنعتاق من آليات الإخضاع القسري (سوى كانت آليات أجنبية أو تدعي الوطنية) ، بل لأن العالم من حولنا كله أصبح يئن مثلنا من وطأة الديكتاتورية المقنعة بشعار الديمقراطية الزائف ، ومن الطبيعي أن ينالنا من معاناة الشعوب الأخرى نصيب ، ومن أجل إستعادة زمام الأمر وتعديل الوضع المعكوس وتوجيه مقود حراكنا التنظيمي نحو غايته الثورية التحررية الساقطة اليوم عن طاولة أدائنا التنظيمي ونضالنا الحالي ، كان لابد من تحديد مفصل الأزمة أي (الجزء) الذي بمعالجته تستعيد أجزاء حياتنا الأخرى عافيتها وسلامتها ، وعليه جاء تشخيصنا للأزمة على أنها تكمن في عملية الدمج القسري لوظيفة السلطتين السيادية والسياسية وجاء العلاج كنتاج لتحديدنا الدوافع على النحو التالي:
المحدد الأول : الدافع السياسي
لم يكن ولن يكون من حق أحد أن يتجاوز الجماعة ويخرج على مقرراتها وقانونها ونظامها الأساسي العادل حتى وإن حدث هذا الخروج تحت رآية العلماء والفلاسفة أو رآية الزعماء والقيادات التأريخية، لأنه من الجهل والضعف والهوان أن نجامل أحد في تزوير حقنا الشرعي المرتبط بتوفير قاعدة التوازن للحياة العادلة الطبيعية التي بدونها تنحرف الحياة الإجتماعية وتتحول الى غابة لا تنصاع فيها الإَّ الى القوة والتهديد ، ويصبح فيها القوي سيد الآخرين والضعيف عبداً خاضعاً للأقوياء دائماً وأبدا ، ومن الخزي والعار والخوف والجبن أن نتجاهل من يسمي هذا الزيف وهذا الإزلال والإخضاع القسري للإرادة الشعبية عدالة القانون وكمال التنظيم السياسي بينما نرى الضعفاء من أبناء شعبنا الأبي يئنون ويسخطون دون حول لهم ولا قوة على إحداث التغيير فهل نحن كذلك ، وللتأكيد على عدم وجود عدالة قانونية وراء هذا الزيف المسمى ديمقراطية غربية سأعكس لكم الوضع على الأقوياء كخيار ديمقراطي (ليذوقوا وضعية الضعفاء لبرهة) … انظر…!؟ كيف يضجون ويطالبوا بالتعديل ويستخدمون قوتهم لاستعادة حقوقهم الماسية لحظة ضياعها منهم حتى ينالوها مجدداً وبالكامل فياللعجب والسخرية ، وعليه ننطلق قاصدين من هذا الوعي التأريخي ومؤمنين بضرورة تصحيح القاعدة التنظيمية المنحرفة هذه من خلال بث قيم تنظيمية جديدة غير مطبقة اليوم على أرض الواقع وغيابها يدل بوضوح على الشرخ الذي أصاب الديمقراطية :
الشرخ الأول :(الديمقراطية التقليدية (النموزج الغربي)):
يتمثل في الطريقة التعسفية التي تُمَارس بها الديمقراطية اليوم وفق هذا النموزج الذي يدْعَم حقوق النخبة ويُهْمِل الحقوق العامة للشعب الذي يغيب عن وعيه حقيقة الممارسة السياسية ، ولعل هذا الدور أصبح يُمَارس بصورة عامة على كافة شعوب العالم وليس حصراً في إرتريا ، فالتعبير الديمقراطي يشير فقط الى حقوق التعددية السياسية أي تعدد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم أو المتداولة له، فأين المساحة المخصصة للشعب ، هل من العدل أن تحكم القلة وتكتفي الأغلبية بالتظاهر والصياح والوقوف طوابير لساعات طويلة على حساب مصالحهم وحقوقهم الأخرى الضائعة … أي سلوك ديمقراطي هذا ؟؟؟! ، لماذ لا يقف نواب البرلمان من عضوية الأحزاب في مثل هذه الطوابير لساعات كي يطالبوا الشعب إنتخابهم لعضوية البرلمان مع كل دورة إنتخابية أو تصبح هذه طريقتهم لإتخاذ أي قرار لإفتقارهم حقاً الصلاحيات السيادية التي لدى الشعب (صلاحيات المؤسس أو المالك) إن أردنا التعامل مع الواقع الحقيقي لعملية التنظيم لا التعامل مع الواقع الوهمي الزائف الذي تم فرضه على الشعوب بالقوة ، ومن يتعجب من هذا النقد اللازع من لدنا فلينظر ما يحدث للمتظاهرون من قبل الشرطة ورجال الأمن (!!!!!؟) ليدرك حقيقة الديكتاتورية التنظيمية المقنعة بمظاهر شكلية لا تمت الى الديمقراطية بصلة .
الشرخ الثاني :(العقد الإجتماعي (وثيقة الحكم)) :
أين هي بنود الوثيقة التاريخية للحكم الديمقراطي التي تعتبر حقاً ملزمة لجميع الأطراف وخاصةً الحكومة كقانون دستوري (أساسي) تستمد منه جميع القوانين حكمها وتأصيلها ، لا يوجد عقد حقيقي يتم توثيقه كأساس قانوني للحكم سوى تلك البنود التي تحمي حقوق السلطة (الديناصورية الخالدة) ولذلك إستحقت أن يتوج عرشها بُدْمَج السلطتين السيادية والسياسية لأن المشرع لهذا العقد من النخبة وله مصلحة في الحكم ليس أكثر ، وبهذا الدمج أصبحت أعمال السيادة من حق النخبة الحاكمة كإمتيازات ماسية تضاف لأعمال السياسة الذهبية تلك التي أُنْتُخِبَتْ من قبل الشعب لتقوم بإدارة شئونها بصورة مهنية وفنية ليس أكثر ، أما إنتقال أطماع النواب الى حد الحديث عن حقهم في أعمال السيادة المخصصة للشعب (أو نوابه الغير منتمين للأحزاب السياسية) فهذا هو ما نسميه مدخل رئيسي لديكتاتورية الحكم وأزمة الشعب ، وبتساهلنا وعدم تصدينا لهذا السلوك الغير ديمقراطي يمنح هؤلاء الطامعين حقوق إضافية ، لينكشف الغطاء بذلك عن مشهد (الإنتخابات العامة) الساعية لتلميع نواب البرلمان أو الرئاسة ، لندرك أنها مجرد مشهد زائف لتأكيد نظرية واهمة عن قداسة النواب من ناحية وررضى الجماهير عن هذا السلوك الغير ديمقراطي من ناحية أخرى، نعم … هذا هو مظهر الحكم وواقع الأمر ، ومن يتساءل بعد كل هذا عن سبب وصفنا لحصر أعمال السيادة على النواب بسلوك ديكتاتوري نقول …؟؟؟
هل سمع المتساءل حتى الآن عن وجود توثيق رسمي لعقد قانوني قائم بين نواب يمثلون الشعب ونواب يمثلون الأحزاب السياسية كطرفي علاقة تنظيمية يتحدد من خلالها الصلاحيات السياسية للحكم (أي صلاحيات الموظف المنتخب من قبل حزبه السياسي وتتحدد بناءاً عليه المدة الرسمية اللازمة لقيامه بأعمال السياسة حسب قدراته الفنية) وتتحدد كذلك الصلاحيات السيادية المخصصة لنواب الشعب وحده (ليقوموا بأعمال السيادة) ، فهل حقاً نحن نؤمن بأن بسيادة الشعب بمعنى لا وجود لمن يشاركه هذه المنزلة (الحكم) لأنه المالك الحصري للمؤسسة التنظيمية (الدولة) ومصدر السلطات جميعها، إذاً … كيف يعقل أن تكون أنت صاحب المؤسسة بينما ينص العقد الإداري بتنفيذ آليات حجر تنظيمي عليك أشبه بالحجرالصحي وذلك لتوظيف النائب ليحل محلك (ويصبح الوريث لك قبل مماتك أو قبل أن تفقد عقلك أو تعلن عن تنازلك الصريح عن المؤسسة من خلال مقايضة قانونية عادلة (حتى)) ، كيف يعقل ذلك ونحن ندرك أن الموظف(السياسي) هو مجرد عامل (فني) لدى المؤسس للمنظمة (أي صاحبها ومالكها) وعليه لا يحق لمن هو كذلك (بأي حال من الأحوال) الإدعاء بأن المالك قد تنازل له عن صلاحيات المؤسس التي تخول لمن يحصل عليها إمتلاك صلاحيات السيادة الحصرية أي القيام بأعمال السيادة، بإختصار إن عملية إحلال النائب محل المالك (الشعب) إحلالاً شاملاً غير منقوص يعني تهميش كامل لإرادة هذا المالك من قبل شخص موظف فقط لإدارة شئون مؤسسته السياسية وحسب لا من أجل الإستيلاء على المؤسسة بكاملها ونزع كل صلاحيات المالك عنها ، هذا ما يجعلنا ننظر الى الأمر على أنه إستعمار ليس أكثر ، والنظام الديمقراطي الذي يقوم على تمهيد الأرضية للإدعاء بذلك لصالح النائب يفقد مصداقيته ،فهل لازال التساؤل السابق قائم..؟ (لماذا هو نظام ديكتاتوري …؟) بالتأكيد ليس قائماً الآن خاصة بعد إدراكنا ديكتاتورية المفهوم (الديمقراطي) الذي يرفض أن يعترف بحق الشعب السيادي كمالك حصري للمؤسسة التنظيمية التي تشكلت لخدمة مصالحه وحقوقه ومكانته التنظيمية العليا فقط، فأين هي الديمقراطية ونحن لا نرى سوى سلوك مؤسسات ديكتاتورية تتقمص ثياب الديمقراطية.
الحل المقترح:(الديمقراطية البديلة (النموزج الإرتري)) :
الديمقراطية البديلة تتميز بكونها تدير الحراك التنظيمي للدولة بلا إنتخابات عامة خاصة بالنواب وبلا دمج بين السلطتين السياسية والسيادية ، كما أنها لا نستطيع وصفها (وفق هذا النموزج) بأنها ديمقراطية مباشر لأن هناك من ينوب عن الشعب لأداء وظيفته السيادية(عبر نواب الشعب) والسياسية(عبر نواب الأحزاب)… بصورة منفصلة !!! ، أي أن البناء التنظيمي للدولة يتشكل من قائمتين رئيسيتين لكل منهما مهام منفصلة عن الآخر ، فالأحزاب السياسية عندما تنتخب نوابها للبرلمان ومن ثم الحكومة عبر التصعيد لعضوية المؤتمر الوطني لا ينتظرها سوى الدور السياسي للحكم ، بينما ينفرد بالدور السيادي نواب آخرين هم أعضاء المؤتمرات المفتوحة المصعدين للمؤتمر التأسيسي ، أي يتم تأطير جميع أفراد الشعب الإرتري داخل هذا الإطار التنظيمي (المؤتمرات المفتوحة) ليعبروا عن فاعلية الكيان التنظيمي للشعب ، وبالتالي عن إمتلاكه صلاحيات مقدرة لحفظ ماء وجهه السيادي وحقوق الحصانة الشرعية التأريخية، حيث يتم ترقية عضوية المؤتمرات المفتوحة عبرآليات تصعيدية من عضوية المؤتمرالمفتوح فرع الحي والمحلية والمنطقة والقرية والإقليم الى مستوى القطر أي الى عضوية مؤتمرالشعب المفتوح (أو المؤتمر التأسيسي) الذي يضم ممثلين من كافة المستويات الجغرافية في الدولة ، ومن خلال هذا المؤتمر (التأسيسي) يتم إنتخاب نواب الشعب الذين لاينتمون الى عضوية الأحزاب السياسية ، ليمارسوا صلاحيات الشعب الإرتري السيادية في الرقابة اللصيقة والمصادقة الدقيقة لكل الإجراءات التفصيلية على مستويات الحكم المختلفة (الرئاسة والوزارة والخدمة العامة) ، وذلك بتصعيدهم من داخل المؤتمر الى عضوية الجمعية التأسيسية التي تعتبر الشق السيادي للبرلمان الإرتري المخصص لنواب الشعب ، حيث يتفرع عن هذه الجمعية مكاتب فرعية (هي مكاتب الرقابة الدستورية) تعمل كجزء من الهيكل الإداري العام لمؤسسات الدولة المختلفة (على مستوى المحلية والمنطقة والإقليم والقطر) ويتم تصعيد المختارين من عضوية المؤتمرات المفتوحة مباشرة لعضويتها حسب التقسيمات الجغرافية التابعة لها ،أما الشق السياسي للبرلمان الإرتري فمخصص لنواب الأحزاب السياسية ويدعى الجمعية التشريعية ، هذا الجزء يتم تصعيد عضويته من المؤتمرات الداخلية للأحزاب السياسية الى مستوى المؤتمر الوطني الجامع لعضوية جميع الأحزاب السياسية المسجلة ، حيث يعتبر كل الأحزاب المسجلة عضوة في البرلمان الإرتري (الجمعية الوطنية) أما عضوية الحكومة (مجلس الوزراء) فتتشكل من ثلث مجموع عضوية الأحزاب المسجلة (إذا كان مجموعها فردي) وربع مجموعها إذا كان المجموع زوجي ، ويترك الأمر للمعالجة الداخلية حسب التوافق التنظيمي بينهم ، وتجرى قرعة الإنتخاب من خلال القرعة السرية بحيث يكتب كل فرد مشارك قائمة بأسماء الأحزاب التي يختارها لعضوية الحكومة على ورقة الإقتراع حسب النسبة المحددة (الثلث أو الربع أو غيره) ويقوم بتسليمها لسكرتارية المؤتمر، وأكبر نسبة من الأصوات يحصل عليها الحزب تتشكل رئاسة المجلس الوزراي من عضويته وأما بقية الأحزاب الحاصلة على أصوات أدنى تحظى بالمقاعد المتبقية في المجلس حسب الترتيب الذي حددته القرعة ، بحيث تكون أولوية الحقائب الوزارية لمن يملك صوت أكبر من الآخر ثم الأقل فالأقل.
هكذا نتجاوز مرحلة العبث بأوراق الإنتخابات العامة وتحميل الشعب حملاً يفوق طاقته بوقوفه طوابير من أجل إنجاز هذه الخطوات البسيطة التي يمكننا إجراءها بهذه البساطة داخل مؤتمرات متخصصة لهذا الغرض لتنتهي أزمة التسويق وحملات التشهير والصراع غير اللازمة والتي تعتبر إنصرافية ، لأن الغاية من الإنتخاب هو خدمة الشعب والقيام بواجب نحوه لا تحويل مجرى الوظيفة الى حلبة تتويج تدفع النواب للسير في طريق منحرف عن الغاية الأساسية .
المحدد الثاني : الدافع القانوني :
إن وجود مكاتب الرقابة والمصادقة الدستورية كتعبير عن وجود سلطة سيادية منفصلة عن السلطة السياسية داخل الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية ، يمنع بالتأكيد حدوث التناقض بين موجهات النصوص القانونية، كوجود نص دستوري أعلى (قانون أساسي) صادر من المؤتمر التأسيسي (أو الجمعية التأسيسية) يكفل الحرية ونص آخر تشريعي أدنى(قانون عادي) صادر عن الجمعية التشريعية أو مجلس الوزراء يهدرها، فبدون هذه الرقابة الدستورية من قبل ممثلي الشعب في الجمعية التأسيسية وآلياتها (مكاتب الرقابة الدستورية العاملة في المستويات الإدارية المختلفة) يمكن ان تتحول الضمانات الواردة في الدساتير والقوانين الأساسية حبرا على ورق .
مثال :
القاعدة الجنائية الموضوعية هي تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة يحدد فيه أنواع السلوك التي لا يجوز للأفراد إتيانها مع تقرير جزاء على مخالفتها فإن القاعدة الجنائية الإجرائية هي قاعدة تهدف إلى تحديد وسائل تطبيق قانون العقوبات تتضمن مساساً بالحريات الشخصية.
هذه القاعدة بشقيها تتعارض تعارضا كاملا مع الحرية الفردية لان حق الدولة في العقاب وتنظيم وسائل الوصول إليه يعلو الحريات الفردية . فإقرار سلطة الدولة في العقاب قد ينتهي إلى تجريد الفرد من ضمانات حريته .ففي النظام الفاشي القانون يأتي من الدولة ويوجد من اجلها مع كونها لا تخضع لأي مبدأ . وفي النظام النازي المبني على سمو الدولة على الفرد حلت السلطة المطلقة محل سيادة القانون للدولة .وفي النظام الشيوعي القانون هو أداة سياسية في يد الدولة الاشتراكية الذي لا قيمة له إلا من خلال كونه أداة لتحقيق الشرعية الاشتراكية
لذلك فان هذه الأنظمة الشمولية حيدت كل القيود التي يمكن أن ترد على سلطة المشرع الجنائي من اجل حماية مصلحة النظام السياسي وتحقيق توجيهاته مما يعني أن منطق القانون ومنطق حقوق الإنسان – في هذه الأنظمة -هما منطقان متعارضان تماماً..
ومن أجل الخروج من هذا التعارض بين القانون الجنائي وحقوق الإنسان يجب أن يكون هناك احتواء متبادل بينهما فكما أن القانون الجنائي يجب أن يحوي حقوق الإنسان حقوق الإنسان بدورها يجب أن تأخذ في الاعتبار مقتضيات وضرورات الحياة في مجتمع منظم.
لذلك فان هناك تكاملية بين حقوق الإنسان والقانون الجنائي ويجب أن تحل محل التصادمية بينهما. فالمشروع يجب أن تتنازعه ضرورتان .. ضرورة قمع ومكافحة الجريمة وضرورة حماية الفرد من تعسف الدولة في استعمالها لحقها في العقاب .
فلا يجب أن تتغلب مصلحة النظام على الحرية الفردية بشكل مطلق ولا يجب أن يكون هناك إطلاق للحريات بشكل يؤدي للإضرار بالآخرين أو بالنظام العام .
وإذا كان الأمر كذلك فإن القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة وإخضاع القوة للقانون يمثل حصنا لحماية الفرد ضد الجريمة من ناحية وضد الدولة من ناحية أخرى مادام مبنيا على إحداث توازن بين مصلحتين :مصلحة حماية الآخرين والنظام العام (القيم) ومصلحة حماية الحرية الفردية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:ما هي الكيفية التي يمكن من خلالها إحداث هذا التوازن؟
هذا ما عبرت عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم لها صدر بتاريخ 23 / 7/ 1968 قررت فيه أن على المشرع الجنائي إيجاد توازن دقيق بين حماية المصلحة العامة للمجتمع واحترام حقوق الإنسان وانه وان كان له تبني قيود على الحريات الفردية إلا أن ذلك يجب أن يكون في مجتمع ديمقراطي وأن تكون هذه القيود مبنية على حاجة ماسة ومتناسبة مع الهدف المشروع الذي يسعي إليه .
مما يعني – حسب حكم هذه المحكمة- وجوب تجنب المشرع الإفراط وعدم التدخل إلا لضرورة وبوسائل تتناسب مع المصلحة محل الحماية .
وإذا رجعنا إلى وثائق وإعلانات حقوق الإنسان فإننا نجدها قد تضمنت وسيلة أكثر وضوحا لإحداث التوازن داخل القانون الجنائي بنصها على ضمانات احترام الحقوق والحريات الفردية يلتزم المشرع الجنائي بالوقوف عندها عند ممارسته لسلطته في تفعيل القاعدة الجنائية (موضوعية كانت أم إجرائية) .
والنص الجنائي الذي ينتهك هذه الضمانات هو نص تعسفي ينتهك التوازن الذي يجب أن يبني عليه القانون الجنائي . بمعني آخر هذه الضمانات يجب أن تشكل مبادئ عامة للقانون الجنائي لا يجوز تجاوزها أيا كانت أداة التشريع فالتطابق بين فئة الحكام والمحكومين لا يلغي الحاجة لضرورة الخضوع لهذه الضمانات ذلك لان هذه المبادئ تهدف لحماية الحرية الفردية سواء كانت أداة التشريع حكومية أو شعبية.
وبالتالي فإن سلطة الشعب لا يمكن أن تكون مطلقة أو خالية من القيود .أي أن الشعب ليس له حرية تامة في أن يضع ما يشاء من تشريعات دون ضوابط.
والقول بغير ذلك يؤدي إلى استبعاد كافة ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مما يعني أن النظام الديمقراطي البديل قد يكون اشد تسلطاً واستبدادأً وأكثر قابلية لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الأنظمة التي تدمج السلطتين السيادية والسياسية في يد الحاكم .
ذلك لان استبعاد وجود مبادئ عليا يتقيد بها المشرع في النظام الديمقراطي البديل يعني إمكانية فرض عقوبات جماعية لا تتقيد بمبدأ شخصية العقوبة وإقرار عقوبات تسري بأثر رجعي غير متناسبة مع العقل المجرم وبدون حكم قضائي ؟ ووضع قيود على الحريات الفردية بغير ضرورة .
وهذا ما لا يمكن قبوله لأن الديمقراطية هي وسيلة للتحرر وليست وسيلة للعسف .
لذلك فإن هناك حاجة ماسة لوضع قيود على سلطة التشريع حتى لو كانت أداة التشريع هذه هي الشعب .كما أن حدوث انفصام بين القاعدة الجنائية وهذه القيود ذات الطبيعية الدستورية سيؤدي إلى موت القاعدة الجنائية ولهذا ندعو الى رقابة فعالة لدستورية القوانين من شأنها أن تمنع صدور قوانين مناهضة للحرية (رقابة سابقة)أو تسمح بإلغائها (رقابة لاحقة)على نحو يكفل حدوث تناغم بين قواعد النظام القانوني ويمنع وجود نص دستوري أعلى يكفل الحرية ونص تشريعي أدنى يهدرها فبدون هذه الرقابة يمكن ان تتحول الضمانات الواردة في الدساتير والقوانين الأساسية حبرا على ورق .
ولضمان احترام ذلك يتم تأسيس محكمة دستورية تختص بدعم رقابة دستورية القوانين .
ولهذا فإن خصوصية النظام الديمقراطي البديل تعالج إشكالية مهمة ( تتمثل في إختلاف إجراءات التبني بالنسبة للقوانين الأساسية والعادية) وذلك بجعل إجراءات تبني القوانين الأساسية لا تختلف عن إجراءات تبني القوانين العادية وبالتالي فان تدرج القاعدة القانونية من قاعدة أساسية إلى قاعدة عادية لا يمكن الاهتداء إليها إلا من خلال (موضوعها) أو من خلال احتواء القانون على نص يشير إلى أنه أساسي لا يجوز الخروج عن إحكامه مما يعني أن السلطة التشريعية تقيد سلطانها بموجهات تشريعية صادرة عن سلطة تأسيسية أعلى منها لإحداث التوازن المنشود بين السلطة السياسية (الحزبية) والسيادية (الشعبية) .
على أن هذه الخطوة هي الضمانة التنظيمية الوحيدة لإحداث العدالة المنشودة وهي الجراحة التشريعية الماهرة التي ستمكننا من تجاوز مرحلة جعل السلطة المختصة بإصدار كافة القوانين واحدة ، وسيمكننا أيضاً من منع حدوث اختلاف من حيث الإجراءات والشروط اللازمة لإصدار القوانين الأساسية وتلك اللازمة لإصدار القوانين العادية .
فاشتراط وجود جمعية تأسيسية (في البرلمان) منفصلة عن الجمعية التشريعية لتبني أو تعديل القوانين الأساسية تتجاوز مهام الجمعية التشريعية المخولة بإصدار أو تعديل القوانين العادية من شأنه أن يحدث التمايز بين السلطة التشريعية والسلطة التأسيسية داخل النظام القانوني الإرتري وبالتالي يكون أساس الرقابة الدستورية للقوانين متمثلة في تدرج القاعدة القانونية وتكون القيود على من يملك سلطة تقييد الحرية (أي الجهاز التشريعي أو التنفيذي أو القضائي أو العسكري).
وفي إطار عدم وجود هذا التمايز بين السلطتين التأسيسية والتشريعية فإن المشرع نفسه الذي أصدر القوانين الأساسية والعادية بإمكانه أن يصدر تشريعات تتعارض معهما ، فمن وضع القيد على سلطته يمكن له أن يزيله ، مما يعنى أنه لا يمكن اعتباره قيداً حقيقياً يحمي الفرد في مواجهة تعسف السلطة ولا يمكن القول بأن المحكمة العليا هي التي تمنعه من إزالة القيد الذي وضعه بمقتضى إرادته بخلاف ما لو كان للمحكمة العليا سلطة إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية المخالفة لما وضعته السلطة التأسيسية من ضوابط .
باختصار لكي يكون للضوابط المقررة لإحداث التوازن بين المصلحة العامة والحريات الفردية معني وفاعلية يجب – حسب وجهة نظرنا- الخروج من فكرة القيد الذاتي أو الخضوع الإرادي للقانون فسلطان السلطة التشريعية يجب أن يتقيد بإرادة أعلى وهو المدخل الذي دعانا الى المطالبة بجمعية تاسيسية لتمارس هذه السلطة السيادية المعبرة عن سيادة الشعب والمستقلة عن سلطة الأحزاب السياسية.
الخاتمة :
المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق الحكام والمحكومين ، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
أسلوب الجمعية التأسيسية
يعتبر أسلوب الجمعية التأسيسية هو أحد الأساليب الديمقراطية المتبعة في وضع وانشاء الدساتير، من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب، والأسس الفكرية التي يستند إليها، وانتشار هذا الأسلوب، وأنواع الجمعيات التأسيسية، وأخيراً تقدير هذا الأسلوب، وذلك وفق الآتي:
مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية
تعود أصول فكرة الجمعية التأسيسية إلى مبدأ سيادة الأمة ، الذي ينكر أن تكون السيادة في الدولة لغير الأمة، وتعتبر هذه الفكرة في جوهرها تطبيقاً حقيقياً لنظام الديمقراطية التمثيلية أو النيابية.ومن مقتضى هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير أن تقوم الأمة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات, بتفويض ممارسة سيادتها لممثّلين عنها ( وهؤلاء يشكِّلون هيئةً يُطلق عليها اسم المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري ) يتولون باسمها ونيابةً عنها وضع قواعد نظام الحكم في البلاد, بحيث يُعدّ الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخَبة الممثِّلة للأمة وكأنه صادرٌ عن الأمة بمجملها, وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذاً بمجرد وضعه وإقراره من قبل هذه الهيئة، ما دامت الأمة قد فوَّضتها بذلك, مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدستور على الشعب لاستفتائه فيها أو أخذ موافقته عليها, إذ أنه بمجرد إقرار الهيئة المذكورة للوثيقة الدستورية في صيغتها النهائية, تصبح هذه الوثيقة نافذةً ودون أن يتوقف ذلك على إقرارٍ من أي جهةٍ كانت.
الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية
كان لفلاسفة القانون الطبيعي وكتَّاب القرن الثامن عشر فضل الدعوة إلى هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير, فقد اعتبروا الدستور بمثابة تحقيقٍ لفكرة العقد الاجتماعي الذي ينشئ الجماعة السياسية ويؤسِّس السلطة العامة فيها, ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع أفراد الجماعة, أي من صنع الشعب في مجموعه, لا من صنع فئة معينة منه . كما أنهم نادوا بالأخذ بهذا الأسلوب وضرورة جعل الدستور من صنع الشعب بحجة أن الدستور هو مصدر السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية . ويترتب على ذلك عدم إمكان إصدار الدستور بواسطة السلطة التشريعية, لأن هذه الأخيرة تستمد سلطتها ووجودها من الدستور, ومن ثم لا يجوز لها أن تضع الدستور أو أن تعدله, فهل يعقل أن تقوم هذه السلطة التي يؤسِّسها الدستور ويهبها الحياة, أن تقوم هي بوضعه ؟! ومن ذلك يخلص هؤلاء الكُتَّاب والفلاسفة إلى ضرورة إتباع وسيلة الجمعية التأسيسية التي تختارها الأمة خصيصاً لوضع الدستور ، ولكننا نضيف إليها ممارسة أعمال السيادة المخصصة للشعب مثل الرقابة اللصيقة والمصادقة الدقيقة لأعمال الحكومة السياسية وقيام الشعب بمهام تأسيسية داخل بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة .
الجمعية التأسيسية على النمط الإرتري (المقترح):
يتميز هذا النوع من الجمعيات التأسيسية بأنه لايمارس وظيفة مزدوجة, لما لذلك من مضار مستقبلية, حيث يعتبر تركيز السلطات التشريعية والتأسيسية بين أيدي نفس الأشخاص ديكتاتورية قابضة وبنفس القدر يمكننا وصف تركيز السلطات السياسية والسيادية في يد الجهاز الحكومي بأنه ديكتاتورية ، لهذا يبرز النموزج الإرتري (المقترح) بقيام الجمعية التاسيسية بدورها التأسيسي (السيادي) ، أي أنها بعد وضع الدستور لديها كذلك مهام الرقابة الدستورية والمصادقة على الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية عبر إجراءات مكاتب الرقابة الدستورية الفرعية، وبالتالي ندرك أنه ليس من إختصاص الجمعية القيام بالأدوار السياسية (التقليدية) المتعلقة بأدوار الحكومة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وبذلك وحده تمارس السلطة السياسية مهامها المنفصلة بوضوح وشفافية وإستقلالية وبدون الخلط بين مهامها الموكولة والمهام السيادية الموكولة للجمعية التأسيسية (داخل البرلمان) ، وبذلك وحده نحفظ حقوق المجتمع الإرتري السيادية التي كانت من قبل مخبئة تحت قبضة المفهوم التقليدي للسلطة السياسية الحاكمة بصورة تعسفية جامعة لكل الصلاحيات التشريعية والتأسيسية ولكل السلطات السيادية والسياسية ليصبح الشعب مجرد نزيل على أرضه ومستأجر لحقوقه وصلاحياته السيادية حسب شروط ومواصفات الحكم التقليدي .
هذا المقال محاولة لتفعيل وعي ثقافي جديد للثورة الشبابية القادمة بعزم لإقتلاع السلطة القهرية
بقلم : عمر عبدالله
الكاتب والمحلل السياسي الإرتري
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=22315


















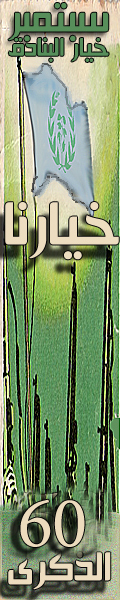
أحدث النعليقات