نظرية الحسبة في النظام الإسلامي أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية
الحلقة الرابعة
إدريس محمد عثمان
الأمة الإسلامية وعناصر البنية الاجتماعي
تعريف الأمــة: الأمة في اللغة كلمة ذكر لها علماء اللسان معاني عدة فمنهم من بلغها إلى أربعين منها : أن الأمة بمعنى الجماعة و منها : أن الأمة الرجل الواحد الداعي إلى الحق. ، وقيل “الأمة كل جماعة يجمعها أمر إما دين أو زمن أو مكان واحد سواء كان الأمر الجامع تسخيرا أم اختيارا.” ،وكل أمة من الناس أرسل إليها رسول ليبلغها رسالة ربه فهي أمة بلاغ ذلك الرسول ومن أجابه منهم و اتبعه فهم أمة الإجابة و من قام بواجب الدعوة إلى دين الله من أتباع الرسول ، فهم أمة الدعوة و من قام بواجب الجهاد في سبيل الله منهم فهم أمة الجهاد، والفريق من الأمة الواحدة إذا اجتمعوا على رأي واحد متميّز افترقوا به عن سائر إخوانهم تطلق عليهم كلمة أمة.
وبهذه المعاني وغيرها ورد مفهوم الأمة في العديد من الآيات القرآنية منها قول الله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وقوله تعالى: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ و قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وهذه الدلالات القرآنية تبين أن الأمة تكون بمعنى الجماعة المتحدة في أهدافها ومقاصدها، وهي في المنظور القرآني عبارة عن تجمع عقدي قيمي ناجم عن تفاعل أفراد من البشر مع مبادئ كلية وقيم عامة تتجاوز الخصوصيات الطبيعية التي تمايز بين الناس من لون أو عرق أو لغة أو إقليم .
أما في الاصطلاح : فإن مصطلح الأمة له تعريفات متباينة بين الفكر الإسلامي وبين النظريات الأخرى التي تتباين منطلقاتها في مفهوم الأمة وتكوين نسيجها الاجتماعي ومن هذه المفاهيم عرّفت الأمة بأنها: ” جماعة ثابتة من البشر نشأت تاريخيا على أساس الاشتراك في اللغة و الأرض والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي الذي يجد تعبيرا عنه في الثقافة المشتركة.”
أو أنها : “جماعة ثابتة من البشر تتألف تاريخيا على شكل تطور اجتماعي ، نشأت على قاعدة الحياة الاقتصادية المشتركة بالارتباط الوثيق على وحدة الأرض واللغة المشتركة وخصوصيات الثقافة والوعي النفسي والقومي .”
وهذان المفهومان المتقاربان في دلالاتهما لمفهوم الأمة القائمة على الأساس الاقتصادي المادي أو اللغة والأرض وإن كانت فيهما جزئيات أساسية تتكون منها الأمة إلا أنهما لا يصح إطلاقهما على مفهوم الأمة بمعناه الدقيق لأن الأمة التي تشكلها هذه المفاهيم ، قد تكون الرابطة فيها قوية إلى حد ما ولكن الرابط الروحي أي الدين قد يفكك أوصال هذه الروابط إذا اختلفت فيه الأمة، إذن الدين يمثل الرابط النفسي والضابط الجماعي في المفهوم الأصح فيما أعتقد ؛ لأنه يتجاوز الرقعة الجغرافية الضيقة لقبيلة أو شعب أو دولة ما، كما هو في الواقع المعاصر حيث إن أكثر شعوب العالم عبارة عن أمم إما صاحبة كتب سماوية أو وضعية “وقد نسميهم باصطلاح الأسماء أمما كثيرة كلما تباعدت بينهم المواطن وتحيزت بهم الحدود و تشعبت بينهم العقائد و اللغات، و لكنهم قبل هذا الاختلاف أمة واحدة لها إله واحد هو رب العالمين.” ومن هنا يأتي التباين في مفهوم الأمة بين الفكر الإسلامي والنظريات الأخرى .
مفهوم الأمة في الفكر الإسلامي:الأمة في المفهوم الإسلامي ولاء وانتساب قائم على العقيدة والمبدأ لا علاقة له بالجنس والدم والقربى ؛ لأن العقيدة في الإسلام رباط يجمع المختلفين في قومياتهم ولغاتهم في أمة واحدة تتجاوز هذه الفروق، ومنطلق هذا التفسير لمفهوم الأمة الأصول الشرعية – القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة – يقول تعالى : } إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ{ عبادة تتجاوز الحدود الجغرافية للأسرة والقبيلة واللغة واللون والجنس لتعرف بالأمة الواحدة الموحدة في كل حياتها روحا ومادة.
وقيام مفهوم الأمة على مبدأ العقيدة في الإسلام لا يعني إغلاق الباب أمام أتباع الأديان الأخرى، فالإسلام : ” مستوعِب وليس العكس، فهو الإطار الجامع لشتات الآخرين وضمن حدوده العامة ،أو ما يعبر عنه فقهاؤنا بالنظام العام، حيث تزاول الحريات والمبادئ والديانات لعدم الإكراه الوارد في قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين { آية في القرآن الكريم تطبق أول ما تطبق عندما يحكم الإسلام قوله تعالى: } وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً { وآية أخرى تستوعب بحروفها وكلماتها الجميع. وتدعوهم إلى التعارف والتعاون كما في قوله تعالى : } يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { وهذه الشعوب والأعراق لا تفاضل بينها في المفهوم الإسلامي ،إلا بالقاعدة الإيمانية التي يعبر عنها القرآن بالتقوى وهي:” كل وازع يزع الضمير وأقدر الناس على أمانة التقوى أقدرهم على النهوض بالتبعية و أعرفهم بمواضع المعروف والمنكر و المباح والمحذور.” فالقاعدة الإيمانية هي الأساس الأول للامتثال والاحتساب ولا وجود للحسبة ما لم تكن القاعدة الإيمانية راسخة في ضمير الفرد قبل المجتمع والدولة باعتبارها أهم الأسباب التي يسعى بها الإنسان في مجاله الروحي كما يسعى بسائر أسبابه الحسية في مجاله المادي ، فإذا أخذ بتقوى الله و ترك الأسباب الحسية فهو جاهل معطل لوجوده الواقعي وإذا أخذ بالأسباب الحسية و ترك تقوى الله فهو فاجر معطل لأسمى أسبابه وأقواها وسنة الله التي رسمها لعباده هي أن تبذلوا الطاقة الروحية والحسية جميعا.
وبهذا التوازن بين الجانبين:الروحي والمادي تتشكل الأمة في مفهوم الإسلام فتتآلف وتلتحم بالرغم من اتساع مجالها الجغرافي واختلاف ألوانها وأجناسها و ألسنتها ولا حدود لمفهوم الأمة في الإسلام بدولة أو لون أو جنس أو رقعة جغرافية بعينها ، فحدود الأمة تقف عند عقيدة التوحيد الخالص التي رسم منهجها الله سبحانه وتعالى وأرسى قواعدها على واقع الحياة محمد e في آخر رسلات الله إلى الناس كافة.
خصوصيات الرسالة الإسلامية
بعد تحديد مفهوم الأمة الإسلامية تلزم الإشارة إلى أهم الخصوصيات التي شكلت الأمة الإسلامية وميّزتها عن سائر الأمم من حيث الدوافع والغايات ،وهي خصوصيات الرسالة الإسلامية ونظرا لتعدد خصائص الرسالة الإسلامية على غيرها من الرسالات الإلهية السابقة ، وبالرغم من التوافق بين هذه الرسالات من حيث المصدر المرسلة منه ، فإن رسالة الإسلام لها طبيعتان ميّزتاها عن سائر الرسالات السماوية التي سبقت رسالة محمد e وهما:
أولاً : طابع الشمول في الدعوة إلى الله بحيث لا تقتصر على فئة ، أو قوم أو جنس بعينه وهذا يعني أنها رسالة لكلّ الناس بخلاف ما سبقها من الرسالات السماوية وفي ذلك إشارة واضحة لانقطاع الوحي السماوي بعدها .
ثانياً: ثبات وشمول أصولها الشرعية في مظانها من القرآن والسنة ، وصلاحية هذه الأصول للزمان كله والمكان كيفما كان وأينما كان .
ولعل في بيان هاتين الخاصتين تتضح بجلاء خصوصيات الأمة التي تنتسب إلى هذه الرسالة الخاتمة وهي تنسجم ونسيج الأمة الاجتماعي وتراثها الحضاري الذي تشكلت منه بالرغم من التباين بين شعوبها إلا أنها مترابطة في نسيجها الداخلي ورؤاها المشتركة في غاية الوجود الإنسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ وهذا النص لقرآني وحده يشكل وحدة الانسجام الداخلي في مفهوم الأمة ولعلّ في بيان هاتين الخاصتين ما يبين ذلك .
أولاً : شمولية الرسالة الإسلامية :-
تهدف الرسالة الإسلامية في شموليتها إلى دعوة القاصي والداني فهي دعوة للناس كافة وهذا ما اختصت به عن سائر دعوات الوحدانية التي سبقت رسالة محمد e إذ الأنبياء والرسل كانت دعواتهم خاصة بأقوامهم وفي حدود أممهم ولم تكن تتجاوزهم إلى غيرهم من الشعوب والأمم كما بين الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وكانت الرسل تترى من بعده داعية إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ،وحدة في المنهج ووحدة في الهدف والغاية وهذه الوحدانية هي التي ختمت بها رسالات السماء بمحمد e ولكن دعوته عليه السلام لم تكن خاصة بقومه وإن كانت بلسانهم ، فهي رسالة شاملة في مضمونها ومنهجها وكاملة في تصوراتها وأبعادها عامة لكل الناس، وهذا بخلاف دعوات الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه في الدعوة إلى الوحدانية كما في قوله تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فدعوة العالمين أبرز خصوصية في رسالة الإسلام إذا ما قورنت بغيرها من اليهودية والنصرانية ،ولم تقتصر رسالة الإسلام في شموليتها على الجانب العقدي فحسب بل وفقت بين الروحيات والزما نيات وشملتها بتفصيل ودقة متناهية فقال تعال: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فالقرآن يحيط ببيانه ويشمل بأحكامه كل ما يحتاج إليه الناس في مسيرتهم الحياتية ، سواء في مظهرها الدنيوي أو مآلها الأخروي ، إذ هو بأحكامه الكلية والجزئية وبقواعده العامة وتوجيهاته الشاملة ،لم يترك شيئا من أمور الناس وقضاياهم إلا وأبانه في توازن وتوافق ينسجم مع فطرة الإنسان .” فما من حدث ولا عمل يصدر عن الإنسان ولا علاقة تقوم بينه وبين غيره إلا وللشريعة حكم فيها فأمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولا تدخل في نطاق تنظيم القوانين الوضعية .” وهذه الشمولية للحياة الإنسانية مدركة من استقراء النصوص الشرعية كتابا وسنة.
ثانياً : ديمومة أصول رسالة الإسلام :-
قد جاءت ديمومة رسالة الإسلام وشموليتها باعتبارها آخر الرسالات الإلهية التي ختم بها الله تعالى سنة الكون في إرسال الرسل فقال تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما وانقطع بذلك الوحي الإلهي بعد اكتمال أصول العقيدة والشريعة ، وقد بين الرسول e ختم النبوة به في الحديث حينما قَالَ : ” إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .” فكانت رسالته عليه السلام من مشكاة الرسالات السابقة وقد جاءت متممة ومكملة ومهيمنة ، وقد دعت إلى الهدف والغاية ذاتها اعبدوا الله ، فرسمت الأصول العقدية للوحدانية ، وإن كانت لها خصوصياتها في جانب التشريع، فهذا دليل على اكتمال دين الله عقيدة وشريعة ومنهجا وشأن القرآن من الكتب السابقة له أنه مهيمن وشهيد عليها وشريعته ناسخة لجميع الشرائع ، فلا هدي إلا هديه ولا شريعة إلا شريعته التي تحيط وتعم جميع قضايا الإنسان ، والحكم به يمثل الحق العدل المطلق. يقول الإمام علي كرم الله وجهه : ” أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ،وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ،وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ”
يتضح من هذا وذاك أن المنهج الإلهي شامل في دعوته كامل في أصوله العقدية والشرعية والأخلاقية و قد طبق على واقع الحياة فكان منهجا ممارسا، بنى أمة لها خصوصيتها التكوينية في الفكر والسلوك تجمعها قواسم مشتركة في مسيرتها الحياتية ومآلها الأخروي ، وفي إطار وحدة المنهج شكل الإسلام حضارة لا تماثلها أية حضارة في تاريخ الإنسانية استوعبت معظم الشعوب والأمم بلغاتها وأعراقها وتقاليدها فصبغتها بصبغة الإسلام، وفي ضوء هذا التصور : فإن السؤال الذي يطرح في واقع الأمة المعاش هو :- كيف تكون أمة لها منهج إلهي كامل في عقيدته وشريعته وأخلاقه ثم هي متأخرة عن ركب الحضارة ؟ ومستوعَبةً وليست مستوعِبةً ؟ ومتأثرة باستمرار مع كثرة عدتها ، وعتادها الحضاري؟ لعل الفرق الشاسع بين الواقع المعاش ، والتاريخ الناصع المدون للأمة الإسلامية يتمثل في عدة أمور أهمها:-
(أ)- بعد أغلب المجتمعات الإسلامية عن روح الشريعة وهيمنة روح الجمود والتقليد.
(ب)- كثرة الفرق الإسلامية وابتعاد مناهجها عن البناء الحضاري بموجهاته القرآنية.
(ج)- الخلافات المذهبية المتجذّرة في المجتمع الإسلامي وانعدام المنهج المشترك.
(د)- الاستعمار الذي تعاقب على أقطار الأمة وجعلها جزيئات صغيرة،أي أقطارا، وأحدث لها مناهج تعليمية في أغلب أقطار الأمة الإسلامية، فككت منظومة المفاهيم والقيم الإسلامية،وأصبح الإيمان بالوطن والقطر والدولة مقدما على الإيمان بوحدة الأمة ومصالحها المشتركة ، ومصيرها المشترك هذه بعض أسباب التخلف عن ركب الحضارة في الواقع المعاش ، وإذا كانت هذه هي أسباب الهدم فما أسس بناء المجتمع الإسلامي ؟ إن مقومات المجتمع الإسلامي الحضاري لا تزال وستظل قائمة وهي تتمثل في مجموعة من المبادئ والأسس يرتكز عليها المجتمع في بنيته الداخلية وسلوكه العام المبني علىمجموعة قيم موزونة بأصول الشريعة ومناهجها ،وهذه المبادئ والأسس تعتبر من المرتكزات التي تحدد ملامح المجتمع الإسلامي يمكن إجمالها في الصور الآتية .
أسس ومرتكزات البنية الاجتماعية
أولاً : عقيدة التوحيد الخالص :
منطلق الأمة الإسلامية في وحدتها وبنائها كان أساسه عقيدة التوحيد التي ضبطها القرآن وأرسى قواعدها النبي e وفق منهج القرآن الذي حدد غاية الوجود الإنساني في هذا الكون في قوله تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ،والعبادة ما لم تكن مقيدة بالتوحيد فهي عبادة باطلة مهما كثرت أو قلت “والمعتبر في التوحيد ليس الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من العمل والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعة والانقياد وتفريغ القلب من شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانيا.” في عقيدته وسلوكه ونظمه وقوانينه ومعاملاته إذ ” لا قيمة لسلوك مهما كان حسنا إذا لم يكن نابعا أصلا من عقيدة صحيحة ، حتى إذا كان السلوك اعتقاديا كان ذا قيمة إنسانية بالضرورة وهذا في نظر العقل والشرع – هو الشان في كل حي سوي.”
وقد تحققت صورة العقيدة السوية في صدر تاريخ الأمة، فبنت مجتمعا مترابطا متينا مبنيا على الحب في الله والبغض من أجل حرمات الله يقوم المعوج على أصل: الدين النصيحة ، فانتشرت فيه العدالة و المودة و المساواة والأخوة الإيمانية إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وهذا هو محور مفهوم الأمة في بنيتها العلائقية وهو يتجاوز رابطة النسب والدم، ويرتبط بالعقيدة باعتبارها الجوهر الذي يتشكل منه عقل الإنسان وقلبه.
فإذا غمرت العقيدة القلب كان صاحبها مسلما وإن قصر في تطبيق التشريع والأخلاق، ولكن يرتكب بذلك إثما يعرضه لعقاب الله تعالى أما إذا لم تتوفر العقيدة الكاملة في يقينه وإدراكه، فإنه لا يعتبر مسلما وإن أفنى عمره كله في العبادة والطاعات وصبغ سلوكه كله بأحكام الشريعة وآدابها. ، وهذا بيّنٌ في قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ولعل هذا الأساس يحتاج في واقعنا المعاش إلى تجديد في أساليب الدعوة إليه وتذكير المؤمنين به لقوله تعالى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وتجديد المفاهيم الإيمانية بين المسلمين أولى من دعوة الكفار إلى الإيمان ؛ لأنّ دعوة غير المؤمنين إلى الإسلام دائرة بين الرفض والقبول ومن هنا كانت إلزامية التذكير حتى لا تنحرف المجتمعات الإسلامية عن منهج الله وتكون القاعدة الأولى راسخة في ضمير كل فرد حتى يكون قادرا على الدعوة لها أو الدفاع عنها وتمثل العقيدة حجر الأساس ومن قصر فيها فقد أبطل غاية وجوده وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من معناها الأصيل.
فالعقيدة في الإسلام هي التي تصلح الفرد و تُطهر روحه و تسمو بفكره، و تجعله عنصرا صالحا مستعدا لبناء مجتمع سليم معافى من كل آفات الأفكار الهدامة ومن العقيدة ينبثق الإيمان بالنظام الإسلامي المتمثل في مجموعة من المبادئ والقيم كالعدالة والمساواة والأخوة ، واحترام كرامة الإنسان وارادته والصدق في التعامل والتسامح وحسن الجوار ومنع جميع أشكال الظلم والاعتداء وتحريم كل أنواع الفواحش والمنكرات.
ثانياً: البناء الأخلاقي :-
إذا كانت قاعدة التوحيد هي أول رباط لبناء المجتمع الموحد ، فالأخلاق هي الصورة المترجمة للقيم الإسلامية سلوكيا ؛لأن البناء الأخلاقي في المنهج الإسلامي له أصوله وقواعده الشرعية الشاملة لمسائل الدين والدنيا ، أساسها العقيدة ، وآليات التشريع، ولعل أهم معيار شرعي لضبط سلوك الفرد والمجتمع والدولة في الإسلام هو مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على أصول الشريعة ومبادئها امتثالا لأوامر الله واحتسابا لما عنده من مثوبة .
والاحتساب بمعناه الأخلاقي هو ” أن يخلص الإنسان عمله لربه يبتغي به رضاه ويقصد به وجهه وحده موقنا بأن تقبل الله العمل أعظم ثواب، وأن ما عند الله يغنيه عن كل الناس وأن ما عند كل الناس لا يغنيه عن الله و هو بذلك لم يراء بالعمل ، ولم يخادع فيه ، ولم يرد به جاها ولا منصبا ، ولا سمعة ولذلك يقوم العبد بالعمل على أحسن صورة ممكنة ، ثم لا يطلب من الناس أي غرض إنما عمله لوجه الله”
ومن هنا يأتي المنهج الشمولي التكاملي بين العقيدة والأخلاق في النظام الإسلامي لبناء الفرد والأسرة والمجتمع بناء فكريا وسلوكيا سليما ؛لأن منظومة الأخلاق الإسلامية متسقة متوائمة مترابطة كحبات العقد لا ينبو فيه صغير ولا كبير بل تلتقي في أنها من الله وتتفق مع الشرع و العقل ،فالبنية الأخلاقية من أهم أسس بناء التراحم والتعاضد في المجتمع الإسلامي كما قال عليه السلام :” مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. ” وهذه البنية التركيبية في المجتمع لا يمكن تحقيقها إلا إذا بني الفرد والأسرة نواة المجتمع بناء عقديا وأخلاقيا . “وحيثما تكن غاية الأخلاق رضا الله تعالى يكن الإصلاح الاجتماعي وتحقيق المصالح واقعا ضمنا؛ لأن الذي يطمع برضاء الله سبحانه و تعالى يكون قد حقق كل صفات الكمال البشرية.” ، فالبنية الأخلاقية هي التي تضع الضمير الإنساني في موضع متوسط بين المثالي والواقعي وتجعله يدمج بينهما دمجا يؤدي إلى تغيير مزدوج في كليهما ففي عالم الواقع يحدث تغيير وهو الاتجاه نحو الأفضل كما أن القاعدة المثالية هي الأخرى باحتكاكها بالحقيقة الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع . وفق معطيات الشريعة التي جاءت أحكامها ونظمها لتغرس صفات خلقية في نفوس من ينتمون إليها والتكاليف التي شرعها الله تعالى كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج هي التي تحرك الوجدان وتوقظ الضمير وتوجه الفرد وتبني الرباط الروحي للأمة إذا ما مورست هذه القواعد على أساس عقيدة سليمة.
ومن أهم الصفات الخلقية التي وضع لها الإسلام ضوابط و قيودا شرعية لبناء مجتمع إسلامي سليم : الصدق و الأمانة ، و الوفاء بالعهد ، و أدب القول و سلامة القلب من الحقد والحسد ، والحلم والصفح والجود والصبر والعفاف واختيار الأصدقاء ، والبعد عن قرناء السوء و العلم … الخ وما من فضيلة خلقية تبني الفرد و الأسرة والمجتمع والأمة إلا ولها ضابط في الشرع الإلهي ، وما من رذيلة إلا ولها مقوم ينكرها ويهدمها ليقيم مكانها الفضيلة ، فالأخلاق في الإسلام ” هي الدين كله و هي الدنيا كلها”
ونظرا لهذا الأثر البليغ للأخلاق في بناء المجتمع فقد مدح بها الله تعالى الرسول e فقال تعالى : وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ومن هذا المنطلق القرآني أصبح من واجب الأمة الاقتداء بالرسول e في كل أقواله وأفعاله بقدر المستطاع دون إفراط يؤدي إلى الغلو أو تفريط يؤدي إلى عدم الالتزام .
وخلاصة ما يمكن قوله في الأساسين السابقين أن أي خلل في العقيدة يؤدي إلى فساد في الأخلاق وفساد في الحياة كلها ، وكل فساد أخلاقي هو ناتج عن فساد عقدي لارتباط العقيدة بنظم الحياة في ثباتها أو تغيرها كما قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم وعلى تغيير الذات في الفرد والمجتمع والتوجه نحو الكمال تؤسس البنية الاجتماعية ولأخلاقية للمجتمع الإسلامي.
ثالثاً: العدالة :-
يمثل العدل القاعدة الشرعية الأساس لبناء مجتمع مترابط ، وهو في اللغة يعنى : الاستقامة وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاختيار عما هو محذور دينا وفي الاصطلاح : العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله . والعدل في منظومة القيم الإسلامية يتجلى في كل مناحي الحياة ؛ لأنه من قواعد الشريعة وأصولها كما يقول ابن القيم : ” الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ، ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، تقوم على العدل ، فهي عدل كلها ، ورحمة كلها ومصالح كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلي ضدها ، وعن المصلحة إلي المفسدة وعن الحكمة إلي العبث ، فليست من الشريعة ، وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه .”
وإذا كان العدل يعد في المجتمع الإنساني من أهم مرتكزات قيامه وبنائه بناء سليما فقد قرر الإسلام هذا المبدأ وجعله من أهم الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه حيث الكل أمام الهدي الإسلامي سواسية ؛ القوي منهم والضعيف في مستوى واحد في مجال الحقوق ، فلا يهضم حق الضعيف لضعفه ولا يترك حقه للقوي لقوته بل يصبح القوي أمام العدالة الإسلامية ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه ، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق t : ” والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ” كما أن العدالة في المنهج الإسلامي لا تختص بها طائفة دون غيرها، بل يستوي فيها المسلم وغير المسلم والذكر والأنثى والصديق والعدو وبذلك وردت الأصول القرآنية فقال تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقال تعالى : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون.
فهذه الأصول تبين شمولية العدالة وارتباطها بالعقيدة و الأخلاق ، ولا يمكن الفصل بين العدالة والعقيدة في الإسلام ، لأن أي عدالة مهما كانت قوانينها ونظمها مالم تكن مرتبطة بالمنهج الإلهي وموافقة لشرعه فهي عدالة زائفة لأن للمنهج الإلهي أكمل مصدر في بنيته ولقيام مجتمع عادل ومحصن من كل التجاوزات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية …الخ
رابعاً : التكافل الاجتماعي :-
التكافل في مقومات الأمة يعني مسؤولية الفرد المسلم والجماعة المسلمة والمجتمع كل منهم إزاء نفسه وإزاء الآخرين ، فالفرد في المجتمع الإسلامي مسؤول عن نفسه كما هو مسؤول عن مجتمعه و يحدد المنهج القرآني مسئولية الفرد عن نفسه حيث يقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ويقول تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة أما تجاه مجتمعه فمسؤولياته تقوم على التعاون والتعاضد لتقوية الروابط الاجتماعية على المنهج المأمور به في العديد من الآيات القرآنية منها : قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب والتكافل الاجتماعي الذي يبنى عليه المجتمع المؤمن يمكن تصوره في حديث رسول الله e “مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى” ، وهذه الصورة تتشكل بالقاعدة الإيمانية إذ يعتبر التكافل من كمال الإيمان كما قال e ” قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.”
و يمثل التكافل صورة من صور الحسبة التطبيقية في تقوية الروابط الروحية والمادية المشتركة بين أفراد المجتمع .” إذ لا يخفى ما للترابط المادي القائم على المصالح المشتركة بين أفراد الجماعة والتلاقي الأخوي المتكرر من آثار عظيمة في تدعيم العناصر الفكرية ، والقلبية ، والنفسية وإبرازها في واقع عملي ملموس و بذلك تكون الشخصية الإنسانية من جميع أطرافها المعنوية و المادية ، الداخلية والخارجية متحدة الاتجاه مجموعة العواطف ، ملمومة الأطراف غير منفصمة ولا مقسمة .” وبذلك يكون بنيان الأمة الإسلامية ، بنيانا متماسكا يشد بعضه بعضا كما مثله الرسول e بقوله ” الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .” وإذا ما تحقق التكافل الاجتماعي على أسس الأخوة الإيمانية تحققت العدالة والمساواة هدفا وغاية للنظام الإسلامي .
خامساً: المساواة :-
وتعني في اللغة المماثلة والمعادلة. وتعد المساواة من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي والنصوص القرآنية و النبوية تؤكد هذا المبدأ كمقوم للجماعة المسلمة والمجتمع الإسلامي يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فهذه النصوص تبين أن الناس متساوون من حيث النشأة ومن حيث المسؤولية عن العمل ولا تمايز بينهم إلا بالتقوى كما قال e : ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَّ بِالتَّقْوَى ” فالمساواة ركن أساسي لقيام المجتمع الإسلامي ومقوم ضروري ببنيته الاجتماعية وعلى أساس المساواة يكون بناء الأمة التي أرادها الله أن تكون خير أمة على الدوام ، كما قال تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وهذا النص القرآني يقرر إقامة هيأة أو هيآت في المجتمع الإسلامي تكون مهمتها الاحتساب لتحقيق هذه الأغراض الثلاثة المذكورة في الآية ، وهي وظائف تقوم على كل منها الهيأة المنوط بها تنفيذها باسم المجتمع الإسلامي وهذه الوظائف الثلاث هي جماع شؤون الحكم في الدولة الإسلامية ، فالدعوة إلى الخير تشمل تحقيق الرخاء والرفاهية وكفالة سعادة الناس وحفظ الأمن وتوفير مطالب الحياة ، والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يشملان كل نشاط الدولة من إرساء العدالة والدفاع عن البلاد ،وإقامة الحدود ، واحترام العقود والوفاء بالعهود وغيرها من الأمور.
خلاصة ما يمكن قوله في مقومات بناء الأمة الإسلامية أنها : تقوم على مرتكزات متينة أساس قاعدتها العقيدة ، و كل نظم حياتها مرتبطة بالإصول الشرعية – كتابا وسنة – و أي تفريط أو إفراط في القاعدة الإيمانية يؤدي إلى خلل في المنظومة كلها ولا تستقيم حياتها خارج النظام الإلهي الذي رسم الكتاب والسنة مبادئه الكلية ، تاركا الفروع والتفاصيل لفهم الأمة واجتهادات العلماء تبعا لظروف كل عصر وعرف كل فئة درءاً للمشقة عن الناس ، وهذه المرونة تعطي المجتمع الإسلامي مساحة لاستيعاب المستجدات الحياتية ليشكلها على ضوء أصوله وقواعده الثابتة.فمحور بناء المجتمع الإسلامي قائم على جملة مبادئ مرتبطة بالعقيدة حتى يكون البناء الذي أراده الله } أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ_ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { فالله تعالى لا ينفي بناء حياة الفرد أو المجتمع على غير العقيدة الصحيحة لكنه بنيان خاو من محتواه الأصل وفطرته السليمة يهوي بصاحبه إلى نار جهنم وهذا بخلاف قواعد بناء المجتمع الإسلامي الذي يرسم غاياته من خلال المنظور القرآني فيحتسب في بنيته لأن” الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى رهبة من عقابه ورغبة في ثوابه كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذي بناه الباني الداعية إلى الكفر بالله والإضرار بالعباد.”
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=22319


















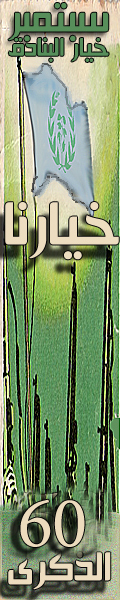
أحدث النعليقات